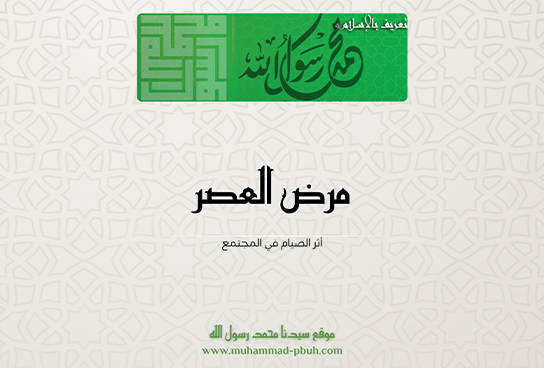اختيار سيدنا عمر له كقائد:
أيها الأخوة الأكارم، مع سير صحابة رسول الله صلى الله علية وسلم، ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا سلمةُ بن قيسٍ الأشجعي.
سيدنا الفاروق، عمر رضي الله عنه، الخليفة الراشد الذي قال عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
فهذا الصحابي الجليل عملاق الإسلام، قضى ليلةً من الليالي سهران، يعسُّ في أحياء المدينة، يتجوَّل، لينام الناس ملء جفونهم آمنين مطمئنين، وكان خلال تطوافه بين الدور والأسواق يستعرض في ذهنه الأمجاد، الأمجاد من صحابة رسول الله، ليعقد لواحدٍ منهم الراية على الجيش الذاهب لفتح الأهواز.
الأهواز الآن تقع في غرب إيران، هذه بلادٌ شاسعة، لكنها جبلية وعرة المسالك، أزمع سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه أن يفتح هذه البلاد، وجهَّز الجيش، وبقي عليه أن يختار له القائد.
ويا أيها الأخوة، من أسباب نجاح أي قائدٍ حُسْنُ اختياره لقوَّاده، ولأعوانه، لأن البطانة إذا كانت صالحة صلح القائد، ومن الأدعية المأثورة، دعاءٌ بصلاح البطانة: اللَّهم هيّئ له بطانة خير، تأمره بالخير، وتدلُّه عليه.
فسيدنا عمر رضي الله عنه كان حريصاً حرصاً بالغاً، على أن يختار قوَّاد الجيوش وولاة الأمصار من بين الأبطال الورعين، الأكْفاء، المستقيمين، المخلصين.
وأنت أيها الإنسان، لو عيَّنوك مدير مدرسة، فبطولتك في حسن اختيار المعلمين، إن أحسنتَ اختيارهم، وكانوا مخلصين، أكْفاء، انطلقتْ هذه المدرسة، في أي مجال، وفي أي عمل، في أعمال الحروب، في أعمال العلوم، في أعمال التجارات، في أي مجال، لن تفلح إلا إذا كان حولك أعوانٌ يجمعون بين الكفاءة والإخلاص.
ومن عادة سيدنا عمر، رضي الله عنه أنه إذا عيَّن والياً يكتب له هذا الكتاب:
خذ عهدك، وانصرف إلى عملك، واعلم أنك مصروفٌ رأس سنتك، وأنك تصير إلى أربع خلال؛ إن وجدناك أميناً ضعيفاً استبدلناك لضعفك، وَسَلَّمَتكَ مِنْ مَعَرَّتِنَا أَمانَتُكْ، وإن وجدناك خائناً قوياً، اسْتَهَنَّا بقوَّتك، وأوجعنا ظهرك، وأحسنَّا أدبك، وإن جمعتَ الجُرمين، جمعنا عليك المضرَّتين، وإن وجدناك أميناً قوياً، زدناك في عملك، ورفعنا لك ذكرك، وأوطأنا لك عقبك
استنبط هذا الخليفة الراشد، هذين المقياسين، الإخلاص والكفاءة، بالتعبير الحديث، أو الأمانة والقوة، بالتعبير القديم، من قول الله عزَّ وجل: ( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)
سيدنا عمر من أسباب نجاحه في الخلافة، أنّه كان يختار ولاة الأمصار، وقوَّاد الجيوش من القمم، فلذلك قال: أريدُّ رجلاً، إن كان أميراً، بدا وكأنه واحدٌ من أصحابه، وإن كان واحداً من أصحابه بدا وكأنه أمير
لشدة حرصه وغيرته على مصالح المسلمين.
فالآن سيدنا عمر يريد أن يعيِّن قائداً لجيشٍ يذهب لفتح بلاد الأهواز، ثم ما لبثَّ، أن هتف قائلاً:
ظفرتُ به، نعم ظفرتُ به إن شاء الله، ولما طلع عليه الصباح، دعا هذا الخليفة العظيم، سيدنا سلمة بن قيسٍ الأشجعي، وقال له: إني وليتك على الجيش المتوجه إلى الأهواز، فَسِرْ بسم الله
وصية سيدنا عمر لسيدنا سلمه لما ولاه القيادة:
أيها الأخوة، دققوا في الوصية التي تكتب بماء الذهب، والتي أوصى بها عمرُ هذا القائدَ العظيم، قال له:
إني وليتك على الجيش المتوجه إلى الأهواز، فسِرْ بسم الله، وقاتلْ في سبيل الله مَن كفر بالله، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا، فإمّا أن يختاروا البقاء في ديارهم، ولا يشتركوا معكم في حرب غيرهم، فليس عليهم إلا الزكاة، وليس لهم في الفيء نصيب، وإمّا أن يختاروا أن يقاتلوا معكم، فلهم مثل الذي لكم، وعليهم مثلُّ الذي عليكم، فإن أبوا الإسلام، فادعوهم إلى إعطاء الجزية، ودعوهم وشأنهم، واحموهم من عدوهم، ولا تكلِّفوهم فوق ما يطيقون، فإن أبوا فقاتلوهم، فإن اللهَ ناصرُكم عليهم، وإذا تحصَّنوا بحصنٍ، ثم طلبوا منكم أن ينزلوا على حكم الله ورسوله، فلا تقبلوا منهم ذلك، فإنكم لا تدرون ما حكم الله ورسوله، وإذا طلبوا منكم أن ينزلوا على ذمة الله ورسوله، فلا تعطوهم ذمة الله ورسوله، وإنما أعطوهم ذممكم أنتم، فإن ظفرتم في القتال، فلا تسرفوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا.
قال سلمة: سمعاً وطاعةً يا أمير المؤمنين،
فودَّعه عمر بحرارةٍ بالغة، وشدَّ على يديه بقوة، ودعا له بضراعة
لأنَّ عمر كان يقدِّر ضخامة المهمة التي ألقاها على عاتقه، وعاتق جنوده.
ما هي الحرب؟ الحرب أن تضع روحك على كفِّك، فإما أن تعود غانماً، وإما أن تموت شهيداً، كلمة موت عند الجبناء شيء مخيف، لكن المؤمنين، لهم شأنٌ آخر، جادوا بأنفسهم، ولله در القائل:
تجُود بالنفسِ إذْ أنتَ الضَّنينُ بها والجودُ بالنفسِ أقصَى غايةِ الجودِ
الصعوبات والنتائج:
أيها الأخوة، مضى سلمة بن قيس، على رأس الجيش الغازي في سبيل الله، غير أنهم ما كادوا يتوغَّلون قليلاً في أرض الأهواز حتى دخلوا في صراعٍ مرير مع طبيعتها القاسية، فقد طفق الجيش يعاني من جبالها الوعرة، وهو مُصْعِد، ويكابد من مستنقعاتها الموبوءة، وهو مسهل.
لقد وجدوا أفاعي وعقارب، وجبالاً وعرة، وسهولاً فيها مستنقعاتٌ آسنة، وفيها حشرات، وأوبئة وأمراض، وأرضًا لا يعرفونها، وعدوًّا يخشون بأسه، وهم خرجوا من الصحراء، من أرضٍ حارةٍ، إلى أرضٍ باردة، هؤلاء هم الصحابة،
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي، اللَّهَ اللـَّهَ فِي أَصْحَابـِي، لَا تَتَّخِذُوهُـمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ
أي دعوني وأصحابي.
كان الصحابة عندما يحاصِرون مدينةً محصنةً لها سور مرتفع، يرجو أحدُهم أخوانه أن يرفعوه إلى قمة الحصن، ويلقي بنفسه إلى داخله، ومَن بداخله؟ أعداءٌ ألدَّاء، معهم السيوف والرماح، ينتظرونه، كي ينهشوا لحمه بسيوفهم، ويقع هذا الصحابي خلف السور، ويضربه الكفار، ستةً وثمانين طعنةً في جسمه، ويفتح باب الحصن، ويستشهد، ماذا فعلنا؟
لذلك هؤلاء الصحابة، رضي الله عنهم، ورضوا عنه، يكفيهم شرفاً أن الله عزَّ وجل اختارهم لصحبة نبيه، اختارهم لصحبة سيِّد الخلق، وحبيب الحق، وشُرِّفوا بأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، وآمنوا به، وعاونوه، وفدوه بأرواحهم.
يا أيها الأخوة، الإيمان يفعل المعجزات، مهما اشتدت المحن، ومهما ضاقت الأمور وتعسَّرتْ، ومهما اكفهرَّت الليالي، واشتدَّت الخطب، إيمان المؤمن أقوى من كلِّ شيء.
فقد كان هذا الصحابي الجليل، والقائد العظيم، يتخوَّل أصحابه بالموعظة، التي تهزُّ نفوسهم هزاً، ويملأ لياليهم بأرج القرآن، فإذا هم مغمورون بضيائه، سابحون في لآلائه، ناسون ما مسَّهم من عناءٍ ونصب.
من يقدر منا الآن أنْ يركب فرسًا، ويمشي في هذه الليالي، من مدينة إلى المدينة وحيداً؟ هكذا كان الصحابة.
النبي عليه الصلاة والسلام، يرسل الصحابي الجليل رسولاً إلى كسرى وحده، الآن تجد الوفد ثلاثين شخصًا، معهم مهمات، طائرات، قاعات شرف، فنادق خمس نجوم، أجنحة، سيارات مع سائقيها، مع مترجمين، الآن هذه المهمة متعة، فيها كلّ شيء، الإكرام شديد، والتعويضات باهظة، واستقبال، وولائم، يقول لك: غداء عمل، أي عمل هذا؟ فلذلك: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ
امْتَثَل سلمة بن قيس لأمر خليفة المسلمين، فما إن التقى بأهل الأهواز حتى عرض عليهم الدخول في دين الله، فأعرضوا ونفروا، دعاهم إلى إعطاء الجزية فأبوا واستكبروا، فلم يبق أمام المسلمين غير ركوب الأسنة، فركبوها مجاهدين في سبيل الله، راغبين بما عنده من حسن الثواب، ودارت المعاركُ حاميةَ الوطيس، مستطيرة الشرر، وأبدى فيها الفريقان مِن ضروب البسالة ما لم تشهد له الحروب نظيراً، إلا في القليل النادر، ثم ما لبثت أن انجلت المعارك عن نصرٍ مؤزَّر للمؤمنين المجاهدين، وهزيمةٍ منكرةٍ للمشركين أعداء الله.
هدية النصر من سيدنا سلمة بن قيس الأشجعي إلى سيدنا عمر بن الخطاب:
أيها الأخوة، ولما وضعت الحرب أوزارها، بادر سلمة بن قيس إلى قسمة الغنائم بين جنوده، ومن بين هذه الغنائم حِليةٌ نفيسةٌ جداً، فهذا الصحابي، هذا القائد المخلص، المحب، المؤمن، الورع، لما رأى هذه الحلية النفيسة، أحبَّ أن يُتْحِف بها أمير المؤمنين، وأن يقدِّمها هدية من الجنود جميعاً لأمير المؤمنين، فما دامت هذه الحلية من حق الجنود، فلا بدَّ أن يستأذنهم، فقال للجنود:
إن هذه الحلية، لو قسِّمت بينكم، لما فعلتْ معكم شيئاً، فهل تطيبُ أنفسكم إذا بعثنا بها إلى أمير المؤمنين؟.
ماذا فعل هذا الصحابي؟ هل ارتكب جريمة؟ لقد قدَّم للخليفة هديةً من حقه، ما دامت من حقِّ الجنود جميعاً، وقد استأذنهم
فقالوا مِن دون تردد جميعا: نعم.
فجعل الحليَةَ في سفطٍ،
ما هو السَّفط؟ صندوق
وندب رجلاً من قومه، من بني أشجع، وقال له: امضِ إلى المدينة،
مِن أين؟ من الأهواز إلى المدينة
اذهبْ وحدك، أنت وغلامك، وبشِّر أمير المؤمنين بالفتح، وأطرِفْهُ بهذه الحلية
أي قدم له هذه الهدية.
أيها الأخوة،
فكان للرجل مع عمر بن الخطاب خبرٌ فيه عبرٌ وعظات، مضيتُ أنا وغلامي إلى البصرة، فاشترينا راحلتين، مما أعطانا سلمة بن قيس، وأوقرناهما زاداً، ثمَّ يمَّمنا وجوهنا شطر المدينة، فلما بلغناها نشدتُ أمير المؤمنين، أي طلبته، بحثت عنه، فوجدته واقفاً يغدِّي المسلمين، طبعاً فقراء المسلمين، وهو متكّئ على عصاه كما يصنع الراعي، وكان يدور على القِصاع، وهو يقول لغلامه يرفأ: يا يرفأ، زِدْ هؤلاء لحماً، يا يرفأ، زد هؤلاء خبزاً، يا يرفأ، زد هؤلاء مرقةً.
سيدنا الصديق رضي الله عنه، كانت له جارة عجوز عندها شاة، فكان يحلبها لها، فلما صار خليفةً، حزنتْ لأن هذه الخدمات لن تستمر، لقد أصبح خليفة، وفي اليوم التالي طرق باب الجارة، وقالت لابنتها: يا بنيَّتي افتحي الباب، فلما فتحت الباب، قالت: مَن الطارق يا بنيتي؟ قالت: جاء حالب الشاة يا أمّاه، وهو خليفة المسلمين.
فلما أقبلتُ عليه، قال: اجلس، فجلست في أدنى الناس، وقدَّم لي الطعام، فأكلّتُ لحمًا، فلما فرغ الناس من طعامهم،
قال: يا يرفأ ارفع قِصاعك، ثم مضى فتبعته، فلما دخل داره استأذنتُ عليه بالدخول، فأذن لي، فإذا هو جالسٌ على رقعةٍ من شعر، أي جلد شعر، نصفه قد قُطِع، ونصفه ما زال موجودًا، متكئٌ على وسادتين من جلدٍ محشوَّتينِ ليفاً، فطرح إلي إحداهما، فجلست عليها، وإذا خلْفه سترٌ، فالتفتَ نحو الستر،
وقال: يا أم كلثوم، ائتنا بغدائنا، فقلت في نفسي: ما عسى أن يكون طعام أمير المؤمنين الذي خصَّ به نفسه؟.
قال: فناولته خبزةً بزيتٍ، عليها ملحٌ لم يدق، ملح خشن، فالتفتَ إليَّ، وقال: كُلْ، فامتثلت، وأكلت قليلاً، وأكل هو،
قال: فما رأيت أحداً أحسن منه أكلاً، ثم قال: اسقونا، فجاءوه بقدحٍ فيه شرابٌ من سويق الشعير، نقيع الشعير،
فقال: أعطوا الرجل أولاً، فأعطوني، فأخذت القدح، فشربت منه قليلاً، ثم أخذه وشرب حتى روي، ثم
قال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا، وسقانا فأروانا.
عند ذلك، التفت إليه، وقلت: يا أمير المؤمنين، جئتك برسالةٍ من عاملك سلمة،
قال: مِن أين؟
قلت: من عند سلمة بن قيس،
قال: مرحباً بسلمة بن قيس، ومرحباً برسوله، حدِّثني عن جيش المسلمين،
فقلت: كما تحب يا أمير المؤمنين، السلامة والظَّفَرُ على عدوهم، وبشَّرته بالنصر، وأخبرته خبر الجيش جملةً وتفصيلاً، هذه هي المهمة الأولى.
فقال: الحمد لله أعطى فتفضَّل، وأنعم فأجزى، ثم قال: هل مررت بالبصرة؟
قلت: نعم يا أمير المؤمنين،
قال: كيف المسلمون؟
قلت: بخيرٍ من الله، قال: كيف الأسعار؟
قلت: بخير،
قال: وكيف اللحم؟
قلت: اللحم شجرة العرب، واللحم كثيرٌ وفير.
قال: ما هذا الذي بيديك؟
قلت: يا أمير المؤمنين، لما نصرنا الله على عدونا، جمعنا الغنائم، فرأى سلمة فيها حليةً، فقال للجند: إن هذه لو قسِّمت عليكم لما بلغت منكم شيئاً، فهل تطيب نفوسكم، إذا بعثت بها لأمير المؤمنين؟
فقالوا: نعم، ثم دفعت إليه بالسفط.
فلما فتحه، ونظر إلى ما فيه، من بين أحمر وأصفر وأخضر، وثب من مجلسه، وجعل يده في خاصرته، وألقى بالسفط على الأرض، فانتثر ما فيه، ذات اليمين، وذات الشمال، فظنَّ النساء، أنني أريد قتله.
ثم قال: قم غير محمودٍ لا أنت ولا صاحبك، قلت: ائذن لي بمركبٍ يحملني أنا وغلامي إلى الأهواز، فقد أخذ غلامك راحلتي، قال: يا يرفأ، أعطني راحلتين من إبل الصدقة، له ولغلامه، ثم قال لي: إذا قضيت حاجتك منهما، ووجدتَ مَن هو أحوج لهما منك فادفعهما إليه،
يعني الراحلتين
قلت: أفعل هذا يا أمير المؤمنين، ثم التفت إليَّ،
وقال: أمَا واللهِ، لئنْ تفرَّق الجند قبل أن يقسم فيه هذا الحلي، لأفعلن بك وبصاحبك الفاقرة.
فمضيتُ من توئي حتى أتيت سلمة، وقلت له: ما بارك الله لي فيما خصصتني به، أقسم هذا الحلي في الجند قبل أن تحلَّ بي وبك داهية، وأخبرته الخبر، فما غادر مجلسه إلا بعد أن قسمه فيهم.
طبعاً سيدنا عمر، لولا أن يكون بهذا الورع، وهذه الشدة، وذلك الحزم، لما أكرمه الله ذلك الإكرام،
قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان عفَّةٌ عن المطامع، عفَّةٌ عن المحارم
استحقاق النصر:
أيها الأخوة، لا تنسوا أنّ ركعتين من ورع، خيرٌ من ألف ركعةٍ من مخلِّط، والإيمان عفةٌ عن المطامع عفةُ عن المحارم، والإنسان لا يرقى عند الله بعلمه، بل يرقى باستقامته، ولا يرقى بعباداته، بل يرقى بورعه، وهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا من الورع والخوف مِنَ الله في مكانٍ عليّ، ولولا أنهم كانوا كذلك لما قدَّر الله على أيديهم النصر.
فإذا أردتم أن ترقوا عند الله عزَّ وجل، وأن تستحقوا نصر الله وتأييده، وأن يكون الدين مسعداً لكم، وأن يجري الخير على أيديكم، فعليكم بالورع والعفة، فهما أساس هذا الدين.
الدين له مظاهر، وله جوهر، جوهر الدين الاستقامة والعمل الصالح، والاستقامة والعمل الصالح، لا يمكن أن يُبْنَيَا إلا على معرفة الله عزَّ وجل.