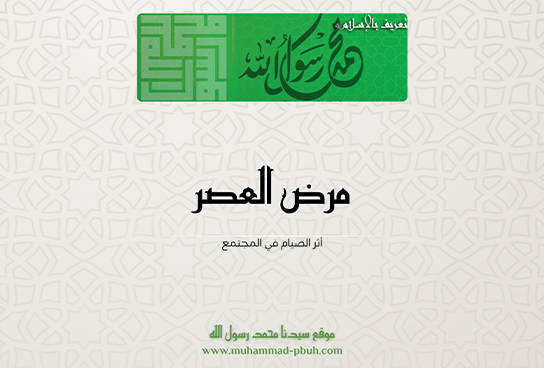الإخلاص و العمل:
أيها الأخوة المؤمنون، مع سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وصحابيُّ اليوم اسمه الذي سماه به أهله زيد الخيل، فلما سأله النبيّ صلى الله عليه وسلم عن اسمه،
قال: أنا زيد الخيل،
فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت زيد الخير،
فسميّ بعد ذلك بهذا الاسم، (زيد الخير).
اخترتُ لكم هذه القصة، كي تستنبطوا منها في نهاية المطاف العبرة،
فعن معاذ بن جبل أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: أوصني، قال: أخلص دينك يكفك القليل من العمل
فمع الإخلاص لله عزَّ وجل ينفعُ كثيرُ العمل وقليله، ومن دون إخلاصٍ لا ينفع لا كثيرُ العمل ولا قليلُه، قال تعالى: ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً)
قال بعض المفسرين: العمل الذي لا إخلاص فيه، لا خير فيه، ومردود على صاحبه.
كرمه وسماحته في الجاهليه:
أيها الأخوة، لكن هذا الصحابيّ الجليل، له في الجاهلية اسمٌ كبير، وكان علَماً من أعلام الجاهلية، وقصته تؤكِّد لكم ثانيةً صحة قول النبيّ عليه الصلاة والسلام في حديثه: تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا، وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ
الناسُ معادن، فزيد الخير، أو زيد الخيل، كما كان اسمه سابقاً، يدعُوه الناس في جاهليته زيد الخيل، فقد حكى الشيبانيّ، وهذه القصة منتزعة من كتب الأدب، كيف كانت حياة هذا الإنسان قبل أن يُسلم؟ عن شيخٍ من بني عامر، قال: أصابتنا سنةٌ مجدبةٌ، هلك فيها الزرع والضرع.
العرب في الجاهلية، مَن هم؟ لا شيء، لقد كانوا فقراء، وعاشوا في الصحراء، كانوا يقتاتون على ما يغنمون في الغزو، وكانوا يقتتلون لأتفه الأسباب، فكان يغزو بعضُهم بعضاً، فسمىَّ الله حياتَهم هذه جاهلية، لأن أساسها الجهل.
قال: فأصابتنا سنةٌ مجدبةٌ، هلك فيها الزرع والضرع، فخرج رجلٌ منا بعياله إلى الحيرة، وتركهم فيهـا، وقـال لهـم: انتظِروني هنا حتى أعود إليكم، ثم أقسم ألا يرجع إليهم، إلا إذا كسب لهم مالاً أو يموت.
نحن، والحمد لله لم نذق الفقر الذي لا يحتمل، ألا تجد شيئاً تأكله؟ كلُّنا يجد، أمّا أن ترى أهلك وأولادك يتضوَّرون جوعاً، ولا تملك درهماً تشتري لهم به طعامًا فهذه مصيبة الدهر، وقاصمة الظهر،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا، وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ
فهذا الرجل الذي ذكره الشيباني، والذي أقسم بالله ألاّ يعود إلى أهله إلا برزقٍ أو يموت جوعاً، فإذا أكرم اللهُ الإنسان بأن يسّر حاجته، كلما شكا ليّ أحدٌ أنّ دخله وسط، أقول له: واللهِ إنّ الله يحبك، لأن دعوة النبيّ أصابتك، النبيُّ عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم من أحبني، فاجعل رزقه كفافاً
الإنسان إن كان رزقه يكفي حاجاته، وهو متفرغ لمعرفة الله، فهذا هو الملك، مرة سأل ملِكٌ وزيرَه، فقال:
مَنِ الملك؟ فتحرّج الوزير، ما هذا السؤال؟ ملِك يسأله: مَنِ الملك؟ فما فهم الوزيرُ مقصدَ الملك، ثم قال له: أنت الِملك، قال له: لا، يا أخي، الِملك رجلٌ لا يعرِفُنا، ولا نعرِفه، رزَقَه اللهُ زوجةً ترضيه، وبيتاً يُؤويه، لأنه إنْ عَرَفَنا جَهِدَ في الخضوع لنا، وإنْ عرفْناه جَهِدْنا في إذلاله، فلا يعرفنا ولا نعرفه.
فهذا الشيخ بلغ من الفقر حداً لا يُحتمل، تزوّدَ زاداً، ومشى يومه كله، حتى إذا أقبل الليل وجد أمامه خِباءً، وبالقرب من الخِباء مُهرٌ مُقيدٌ، يعني فرسًا أصيلة، فقال: هذا أول الغنيمة، وتوجه إليه، وجعل يحُلُّ قيده، فما إن همَّ بِركوبه، حتى سمع صوتاً يناديه: خلِّ عنه، واغنمْ نفسك، فتركه ومضى، فما نجحتْ معه المغامرة، ثم مشى سبعة أيام، حتى إذا بلغ مكاناً فيه مراحٌ للإبل، وبجانبه خِباءٌ عظيم، فيه قبةٌ من أدمٍ، تشير إلى الثراء والنعمة.
فقال هذا الرجل الشيخ في نفسه: لا بدَّ لهذا المراح مِن إبل، ولا بد لهذا الخِباء من أهل، ثم نظر في الخِباء، وكانت الشمس تدنو من المغيب، فوجد شيخاً فانياً في وسطه، فجلس خلفه، وهو لا يشعر به، وما هو إلا قليل حتى غابت الشمس، وأقبل فارِسٌ لم يُرَ قطُّ فارس أعظم منه، ولا أجسم منه، قد امتطى صهوةً، وحوله عبدان يمشيان عن يمينه وشماله، ومعه نحو مئةٍ من الإبل، أمامها فحلٌ كبير، فبرك الفحلُ، فبركت حوله النُوقُ.
وهنا قال الفارِس لأحد عبديه: احلبْ هذه، وأشار إلى ناقةٍ سمينة، واسقِ الشيخ، فحلب منها حتى ملأ الإناء، ووضعه بين يدي الشيخ، وتنحىَّ عنه، فجرع الشيخ منه جُرعةً أو جُرعتين، وتركه،
قال الرجل: فدببت نحوه متخفياً، وأخذت الإناء وشربتُ كلَّ ما فيه، فرجع العبد، وأخذ الإناء،
وقال: يا مولاي، لقد شربه كله، -يعني والده-
فقال الفارس: احلب هذه، وأشار إلى ناقةٍ أخرى، ووضع الإناء بين يدي الشيخ، ففعل العبد ما أمر به، فجرع منه الشيخ جرعةً واحدة وتركه.
قال الرجل: فأخذته وشربت نصفه، وكرهت أن آتي عليه كلِّه، حتى لا أثير الشكَّ في نفس الفارس، ثم أمر الفارسُ عبدَه الثاني، بأن يذبح شاةً، فذبحها، فقام إليها الفارس، وشوى للشيخ منها، وأطعمه بيديه، حتى إذا شبع، جعل يأكل هو وعبداه.
وما هو إلا قليلٌ حتى أخذ الجميعُ مضاجعَهم، وناموا نوماً عميقاً له غطيط، عند ذلك توجَّهتُ إلى الفحل، والفحلُ إذا تحرّك تحرّكتْ معه النوقُ كلها، فحللتُ عقاله، وركبتُه فاندفع، وتبعته الإبل، ومشيتُ ليلتي، فلما أسفر النهار نظرتُ في كل جهةٍ فلم أرَ أحداً يتبعني، فاندفعت في السير، حتى تعالى النهار، ثم التفتُ التفاتةً، فإذا أنا بشيءٍ كأنه نسرٌ أو طائر كبير، ما زال يدنو مني حتى تبيَّنتُه، فإذا هو فارسٌ على فرس، ثم ما زال يقبل عليَّ حتى عرفت أنه صاحبي جاء ينشد إبله، عند ذلك عقلتُ الفحل، وأخرجتُ سهماً من كنانتي، ووضعتُه على قوسي، وجعلتُ الإبلَ خلفي، فوقف الفارس بعيداً،
وقال لي: احْلُلْ عقالَ الفحل،
فقلت: كلا، لقد تركت ورائي نسوةً جائِعات بالحيرة، وأقسمتُ ألاّ أرجع إليهن إلاّ ومعي مالٌ أو أموت،
قال: إنك ميِّت، احْلُلْ عقال الفحل، لا أبا لك،
فقلت: لن أحلَّه،
فقال: ويحك إنك لمغرور،
ثم قال: دلِّ زمام الفحل، أي أَرْخِ زمام الناقة، وكان فيه ثلاث عقد، ثم سألني في أية عقدةٍ منها تحبُّ أن أضع لك السهم
قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ
قال له: فأشرت إلى الوسطى، فرمى السهم فأدخله فيها، حتى لكأنما وضعه بيده،
أي إنه رامٍ من الطراز الأول،
ثم أصاب الثانية والثالثة، عند ذلك عرفتُ قوته، فأعدتُ سهمي إلى الكنانة، ووقفتُ مستسلماً، فدنا مني، وأخذ سيفي وقوسي،
وقال: اركَبْ خلفي، فركبت خلفه،
فقال: كيف تظن أني فاعلٌ بك؟
قلت: أسوأ الظن،
قال: ولِمَ؟
قلت: لما فعلته بك، وما أنزلتُ بك من عناءٍ، وقد أظفرك الله بي،
فقال: أو تظن أني أفعل بك سوءًا، وقد شاركتَ مُهلْهِلاً في شرابه وطعامه، ونادمته تلك الليلة، فلما سمعت اسم المهلهل،
قلت: أزيد الخيل أنت؟
قال: نعم،
قلت: كن خير آسر،
قال: لا بأس عليك، ومضى بي إلى موضعه،
وقال: واللهِ لو كانت هذه الإبل لي لسلَّمتها إِليك، ولكنها لأُختٍ من أخواتي، فأقِمْ عندنا أياماً، فإني على وشك غارةٍ، قد أغنم منها،
هكذا كان العرب في الجاهلية يعيشون.
وما هي إلا أيامٌ ثلاثة حتى أغار على بني نمير، فغنم قريباً من مئة ناقة، فأعطاني إياها كلَّها، وبعث معي رجالاً من عنده يحمونني، حتى وصلت الحيرة.
هذه قصَّته في الجاهلية، فارس من أكابر فرسان العرب، ذو مروءة، شهم، شجاع، رامٍ ممتاز، هذا لا يعنينا، لكن ذكرتُ هذه القصة تمهيداً للقصة الثانية، تلك كانت صورة زيد الخيل في الجاهلية.
زيارته المدينة واسلامه:
لمَّا بلغت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، سمع زيد الخيل، ووقف على شيءٍ مما يدعو إليه.
فالإنسان أيها الأخوة، إذا بلغه الحق، ولم يستجب له، يعدُّ أحمقَ، لأن هذه الفرصة ربما لا تتكرر، فإذا دُعيتَ إلى الحق فاستجِبْ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ)
الإنسان قبل أن يعرف الله ميِّت، قال تعالى: ( أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ)
أما إذا عرف الله عزَّ وجل، فقد أصبح حياً، مثل المؤمن وغير المؤمن كمثل الحيِّ والميِّت.
سأسألكم سؤالاً: لو أن أحداً فتح صندوقَ بريده، فإذا فيه رسالة، فهل مِنَ الممكن أنْ يمزِّقها قبل أن يقرأها؟ هل تجدون في الأرض كلِّها إنساناً واحداً يتلقَّى رسالةً، فيمزُّقها قبل أن يقرأها؟
أنا أتعجَّب مِن هذا الذي يرفض الإسلام قبل أن يتعلَّمه، يرفض الدين قبل أن يطَّلع عليه، يرفض القرآن قبل أن يفهم تفسيره، هذا الذي يرفضُ الدين، أو يرفض القرآن، أو يرفض الإسلام، أو يتَّهم الدين بتُهمٍ ما أنزل الله بها من سلطان، قبل أن يتعلَّم، قبل أن يتمكن، قبل أن يعلم، قبل أن يقف على حقيقته، هذا إنسان مجنون، يشبه تماماً ذلك الذي مزَّق الرسالة قبل أن يقرأها
أعدَّ راحلته، ودعا السادة الكبراء من قومه إلى زيارة يثرب.
أيها الأخوة، كل واحد له دور اجتماعي، الأب غير الابن، والمعلّم غير الطالب، والمدير العام غير الموظف، ورئيس الدائرة غير الكاتب، والإنسان كلما علا منصبه، أو علت مرتبته، إن أساء يضاعفْ له العذاب، وإن أحسن يضاعفْ له الثواب.
حتى إنني أقول: هناك حِسابٌ خاص لمن كانوا قادة، الأب إذا أخطأ تبعه أولاده، الأم إذا أخطأتْ، فلم تنضبط بشريعة الإسلام تتبعها بناتها، لذلك فحساب القدوة حسابٌ خاص، يؤخذ هذا من قوله تعالى: ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً)
سيدنا زيد الخيل، جمع سادة قومه، ودعاهم إلى زيارة يثرب، ولقاء النبيّ عليه الصلاة والسلام، بالمناسبة في القرآن آية كريمة دقيقة جداً، قال تعالى: ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ)
صدقني أيها الأخ الكريم، إذا استقمت على أمر الله استقامةً تامةً، تلتقي مع أهل الحق لقاءً عفوياً، فتُحبهم، وتثق بهم، وتُصدِّق دعوتهم، تعينهم وأنت لا تدري، إنه تطابق عفوي، أما كل مَنْ يُقيم على معصية، يُعادِيهم من زاوية هذه المعصية، فكلما اتسعت دائرة المعاصي، اتسعت معها دائرة بغضاء أهل الحق، فلو أنّ إنسانًا يأكل الرِبا، وجلس مع مؤمن، وتحدَّثا في هذا الموضوع، وآكلُ الربا مُصر على عمله، ويقول: أنت لا تفهم في هذا، وأنت مُتزمِّت، واتّهمه بالجهل، وعدم الفهم، إذًا: من أين جاءت هذه العداوة، وهذا التكذيب، وهذا الإنكار؟ من اقتراف المعصية، فإذا أردتَ أن تتعرف إلى أهل الحق فاستقم على أمر الله، فتلتقي معهم لقاءً عفوياً، وتحبهم من أعماق قلبك، لأن المنافق دائماً يكره المؤمن، وكل إنسان يرتكب المعاصي سراً، ويُظهر الطاعة علانيةً، فهذا إنسان مُنافق، والمنافق دائماً يُبغضُ أهل الإيمان، فإذا تغيَّر قلبك، فاعلم أنه لمعصيةٍ وقعت منك، ما تحابَّ اثنان، ثم افترقا، إلا كان أشدهما حباً لصاحبه أقربهما لله عزَّ وجل، الأقل محبة، هو الأكثر معصية، والأكثر محبة هو الأكثر استقامة.
ركب زيد الخيل، ومعه وفدٌ كبيرٌ من طيِّئ، فيهم زر بن سدوس، ومالك بن جُبير، وعامر بن جوين، وغيرهم، وغيرهم، فلما بلغوا المدينة، توجَّهوا إلى المسجد النبويّ الشريف، وأناخوا ركائبهم ببابه، وصادف عند دخولهم أن كان عليه الصلاة والسلام، يخطبُ المسلمين على المنبر، من فوق المنبر،
يعني جاؤوا وقت خطبة الجمعة،
فراعهم كلامه، وأدهشهم تعلُّق المسلمين به.
أقول لكم بصراحة: أنتم في هذه المجموعة إذا كنتم في محبة شديدة، في مؤاثرة، في تضحية، في مسامحة، كلٌ منكم يلتمس لأخيه العذر، كلٌ منكم يحب أن يرقى أخوه، فالحب بين المؤمنين علامة الإيمان، أما البغضاء، والتحاسد، والطعن، والتشكيك، وإيقاع المشكلات بين المؤمنين، فهذا المجتمع لا يرضى الله عنه، ولا يرضيه، ولا قيمة له عند الله.
يا أيها الأخوة، نحن أُسرة، أُسرة بكل معنى الكلمة،
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ
قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،:
مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَـةً مِنْ كـُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِـمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
فما أبصرهم النبيّ عليه الصلاة والسلام،
لقد كان النبيُّ فطنًا، والأنبياء كلهم فطِنون
ورأى وفدًا يدخل المسجدَ أول مرة، حتى أدار بعض الكلام وخاطبهم به، فقال: إني خيرٌ لكم من العُزَّى، ومن كل ما تعبِدون، إني خيرٌ لكم من الجمل الأسود، الذي تعبِدونه من دون الله.
فما الجمل الأسود؟ كل عصر فيه شيء ثمين، الآن يقولون لك: ما ثمن الأخضر اليوم؟ ويبدو أن الجمل الأسود، كان أغلى أنواع الجمال.
فأنت أيها المؤمن، إنْ كنتَ في جلسة، ودخل شخص فلا تهمله، انتبه له، خاطبه، إن رأيته مثقفاً ثقافةً عاليةً، وأنت داعية، حدِّثه بالعلم، فلا يجوز أن تُخاطب المُتعلم بأشياء ربما تُبعده عن الدين، كل إنسان خاطبه بلغةٍ يفهمها، فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يخطب على المنبر، قال ما قاله للقادمين؛ زيد وصحبه.
أيها الأخوة، لقد وقع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس زيد الخيل ومَن معه موقعين مختلفين، بعضهم استجاب للحق، وأقبل عليه، وبعضهم تولَّى عنه، واستكبر عليه، قال تعالى: ( فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ )
أما زر بن سدوس فما كاد يرى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في موقفه الرائع، تحُفُّه القُلوب، وتحوطه العيون، حتى دبَّ الحسدُ في قلبه، وملأ الخوف فؤاده، ثم قال لمن معه: إني لأرى رجلاً ليملِكن رِقابَ العرب، واللهِ لا أجعلُه يملك رقبتي أبداً، ثم توجَّه إلى بلاد الشام، وحلق رأسه وتنصَّر: ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً)
أما زيدٌ والآخرون، فقد كان لهم شأنٌ آخر، الآن بدأت القصة، فما إن انتهى النبيّ عليه الصلاة والسلام من خطبته، حتى وقف زيد الخيل بين جُموع المسلمين، وكان من أجمل الرجال، وأتمِّهم خلقةً، وأطولهم قامةً، حتى إنه كان يركب الفرس، فتمَسُّ رجلاه الأرض، كما لو كان راكباً حماراً، وقف بقامته الممشوقة، وأطلق صوته الجهير،
وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، فأقبل عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم،
قال: مَن أنت؟
قال: أنا زيد الخيل بن مُهلهل،
فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت زيد الخير، لا زيد الخيل، الحمد لله الذي جاء بك من سهلِكَ وجبلك، ورقق قلبك للإسلام
ثم أسلم مع زيد جميعُ مَن صحِبَه مِن قومه.
وصف النبي لزيد:
فعُرِف بعد ذلك بزيد الخير، ثم مضى به النبيّ عليه الصلاة والسلام إلى منزله،
والنبي علمنا هذا الأدب،
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ
فالقادم عليك أول مرة لا بد أنْ تعرفه، وعليك أنْ تدعوَه إلى بيتك، وأنْ تحترمه، وهذه من حكمة المؤمن-.
مضى به النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزله، ومعه عمر بن الخطَّاب، ولفيفٌ من الصحابة، فلما بلغوا البيت طرح النبي عليه الصلاة والسلام لزيدٍ متَّكأً.
أيها الأخوة، أكثر ما أدهشني في هذه القصة هذا الموقف، كم مضى على إسلامه؟ نصف ساعة، أو ربع ساعة، والنبيّ إكراماً له طرح له مُتكأً، وسادة
فعظُم عليه أن يتكئ في حضرة النبيّ عليه الصلاة والسلام،
وقال: واللهِ يا رسول الله، ما كنتُ لأتكئ في حضرتك،
هذا هو الأدب، لكنْ متى تعلمه؟ لم يمضِ على إسلامه ربعُ ساعة، المسلم كلُّه أدب.
وردّ المُتَّكأ وما زال يُعيده إلى النبيّ، وهو يرُدّه، ولما استقر بهم المجلس،
قال عليه الصلاة والسلام لزيد الخير: يا زيد ما وصِف لي رجلٌ قط، ثم رأيته، إلا كان دون ما وصف، إلا أنت.
قال له: يا زيد، إنّ فيك خصلتين، يحبهما الله ورسوله،
قال: وما هما يا رسول الله؟
قال: الأناة والحلم .
هذه صفاتٌ يحبها الله، أمّا هذا الطائش، والعجول، والغليظ، والمتكبِّر، فلا يرتاح إليه الناسُ، بل مَن كان فيه أناة وحلم فهو المقبول عندهم
فقال زيد الخير وكله أدب: الحمد لله الـذي جعلنـي على ما يُحب الله ورسولـه،
ثم التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أعطني ثلاثمئة فارس، وأنا كفيلٌ لك، بأن أُغير بهم على بلاد الروم، وأنال منهم،
فأكبر النبيّ عليه الصلاة والسلام، همته هذه، وقال له: لله درُك يا زيد، أيّ رجُلٍ أنت؟!.
شيء عظيم جدا، أن يحبك رسول الله، وأن يُعجب بك، ولمّا همّ زيدٌ بالرجوع إلى بلاده في نجد ودَّعه النبيّ عليه الصلاة والسلام وقال بعد أن ودَّعه:
أيّ رجُلٍ هذا؟ كم سيكون له من الشأن، لو سلم من وباء المدينة؟.
وفاته:
أيها الأخوة، كان في المدينة أوبئة، وكانت المدينة المُنورة موبوءةً بالحمى، فما إن برحها زيد الخير حتى أصابته،
فقال لمن معه: جنِّبوني بلاد قيس، فقد كانت بيننا وبينهم حماقاتٌ من حماقات الجاهلية،
وتابع زيد الخير سيره نحو ديار أهله في نجد، على الرغم من أن وطأة الحمَّى كانت تشتد عليه ساعةً بعد أُخرى، فقد كان يتمنَّى أن يلقى قومه، وأن يكتب اللهُ لهم الإسلامَ على يديه، وطفِق يسابق المنية، والمنية تُسابقه، لكنها ما لبِثت أن سبقته، فلفَظَ أنفاسه الأخيرة في بعض الطريق، ولم يكن بين إسلامه وموته مُتسعٌ.
عن معاذ بن جبل أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: أوصني، قال: أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ
هذا سيدنا زيد، لقد كان مُخلصًا، وما عاش بعد إسلامه طويلاً، قد مات في الطريق إلى أهله، فالإنسان عليه أن يُخلص، والمُخلٍص في أعلى مقام عند الله عزَّ وجل، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون مُخلصين، وأن يبعدنا عن الرياء والنفاق.