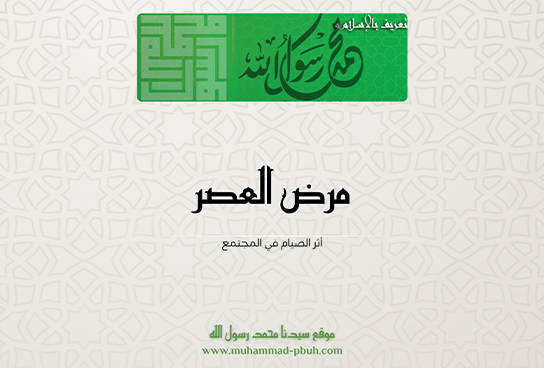قال عليه الصلاة والسلام: “أنا مدينةُ العلم وعليٌ بابها” وكلما قرأنا من أقوال الإمام قولاً وجدنا في هذا القول مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام, فيقول هذا الإمام الجليل:
"من كرُمتْ عليه نفسُه هانت عليه شهواتُه", أيْ: مَن عَرَف قدرَ نفسِه، ومن عرَف سرَّ وجوده، ومن عرف, لماذا خلقه الله عزّ وجل؟ ومن عرف عظمة الدار الآخرة وما فيها من نعيمٍ مقيم، ومن عرف أنه المخلوق الأول والمكرَّم والمكلَّف يضع شهواته تحت قدمه، وهذه هي البطولة. بعضهم لخص الحضارة الإسلامية بكلمتين, فقال: سيطرةٌ على الذات. بالمناسبة ما كان الله ليعذب قلباً بشهوةٍ ترَكها صاحُبها في سبيل الله، أيُّ إنسان إذا شعر بنزوعٍ نحو شهوةٍ ما، وترك هذه الشهوةَ لله، فما كان الله ليعذب قلبه بهذه الشهوة، بل إنّ الله سبحانه وتعالى يرزقه حلاوةً في قلبه إلى يوم يلقاه، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: " من غض بصره عن محارم الله رزقه الله حلاوةً في قلبه إلى يوم يلقاه ". فأنت إنسانٌ لك جسم، ولك نفس، جسمك له طباع، ونفسك لها خصائص، نفسك مفطورةٌ على معرفة الله وعلى طاعته، وجسمك مفطورٌ على الراحة، لذلك كل التكاليف تتناقض مع طبيعة الإنسان، وكل التكاليف تتوافق مع فطرة النفس، فالفطرة متوافقةٌ مع الأمر والنهي، الإنسان لا ترتاح نفسه إلا إذا أطاع الله عزّ وجل، لكن جسمه قد تتناقض حاجاته مع الأمر والنهي ، الصيام يتناقض مع حاجات الجسد، غض البصر يتناقض مع حاجات الجسد، إنفاق المال يتناقض مع حاجات الجسد، أداء الصلوات يتناقض مع حاجات الجسد، إذًا: هذا معنى قول الله عزّ وجل: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾.
ويقول هذا الإمام الكبير: "زهدك في راغبٍ فيك نقصان حظ، ورغبتك في زاهدٍ فيك ذل نفسٍ ", عوِّد نفسك أن الذي يقبل عليك أعطه اهتمامك، أعطه حبك . فإذا صاحبت من يعرفون قدر إيمانك، وأنت مؤمن، ودخلُك محدود فهؤلاء أنت عندهم مكرَّم، إن صاحبت أهل الغنى ممن هم ضعاف الإيمان لا يرون لك قيمةً عندهم، أول سؤال يواجهونك به عن دخلك، فإذا كان دخلك قليلاً ازْوَرُّوا عنك، هم زاهدون فيما عندك من إيمان ومن علم ومن حكمة، فلتُصاحِب المؤمن، يَقُولُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لا تُصَاحِبْ إِلا مُؤْمِنًا وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلا تَقِيٌّ”. فمن ضعف تفكير الناس أنهم يعطون الدنيا حجماً كبيراً, فيقولون لمن كان غنياً فيها: هنيئاً له، مثال ذلك قارون, قال تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾.
ويقول هذا الإمام الجليل: "الإيمان أنْ تُؤثِر الصدق حيث يضرُّك على الكذب حيث ينفعك، وألا يكون في حديثك فضلٌ على عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك", عليه مبلغ من المال دَيْنًا، ومع خصمه سندٌ، وخصمه إنسان مُخيفٌ، فإن لم يدفع هذا المبلغ أقام عليه دعوى، وحَجَزَ على أملاكه، وَشَوَّه سمعته، فإذا بادر إلى دفع هذا المبلغ نجا وحفظ قدْرَه، وهذا سلوك مدني، أما الأمانة فهي غير هذا، فهذا أمين، لأنه يتعامل مع الله سبحانه ، إنسانًا أعطاك مبلغًا ضخمًا من دون أن يأخذ منك إيصالاً، ومن دون أن يُعلِم أحداً من البشر، حتى أهله، ثم مات فجأةً، فذهبتَ إلى الورثة بعد موته، وقلت لهم: إن هذا المبلغ أمانةٌ لكم عندي فخذوه، هذه هي الأمانة، أي أنك لست مُداناً في الأرض. فالإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك, هذا هو الإيمان, كلما تطابقَ الحديثُ مع العمل كنتَ أقربَ إلى الإيمان، وكلما صار ازدواجية، وجرى الكلام للاستهلاك، وكنتَ في وادٍ آخر، فهذا بعدٌ عن الإيمان .
قال هذا الإمام الجليل: "الغيبة جُهد العاجز", أي أن الناجح في حياته، الموفَّق هذا ليس عنده وقتٌ ليغتاب الناس، لأن الوقت ثمين، الوقت أثمنُ شيء في حياة المؤمن، لأن رأس مالك هو الوقت، فأنت بالوقت تعرف الله، بالوقت تزداد علماً، بالوقت تزداد قرباً، بالوقت تزداد عملاً، بالوقت تصطلح مع الله، بالوقت تتوب، فأنت وقت، أو الوقــت غلاف عملك، ودائماً وأبداً ضع في ذهنك أن أتفه أعمارك هو العمر الزمني، أي المسافة الزمنية بين الولادة والموت، لكن العمر لا يقيَّم بهذه المسافة الزمنية، أو هذه المدة الزمنية، بل يقيم بحجم العمل الصالح، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح, والدليل قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾. الإنسان إذا جاءه ملك الموت لا يندم إلا على عملٍ صالحٍ فاته، فلذلك: "الغيبة جهد العاجز", الإنسان التافه العاجز الذي لا ليس عنده شيء يقدمه للأُمة، و ليس عنده شيء يقدِّمه لربنا عزّ وجل، بل شغْلُه الشاغل هو أنْ يقيِّم الناس وينتقدَهم، فضلاً أنّ هناك نهياً قرآنياً واضحاً بألاَّ يغتب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾.
قال هذا الإمام: " الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها "، ليست هي هدفاً، ليست مقصودةً لذاتها، أيْ إذا أردت الدنيا للدنيا فهي أحقرُ مِن أن تُطلَب، لكنك في الدنيا تعرف الله، وفي الدنيا تعمل الصالحات، وفي الدنيا تصطلح معه، لذلك يوم القيامة إذا دخل المؤمنون الجنة: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ فالجامعة, هل هي مقصودة لذاتها؟ لا، قد يكون الجو في الجامعة غيرَ مريح، الجوُّ أميلُ للبرد، والمقعد غير وثير، لأنه خشب، وليس للمسند انحناء، بل إنه زاوية قائمة, أما المقعد المريح جداً فهو في البيت، وفي القصور، وفي الفنادق، فالجامعة ليست مقصودة لذاتها، يجب أنْ تتخذها مطيةً للعلم والمعرفة، وكذلك الدنيا، فالدنيا عند المؤمن محبَّبة، ولكن لا يحبها لذاتها، بل يحبها لأنها طريقٌ إلى الجنة، يحبُّ الزواج لأنه بالزواج يعمل الصالحات، بالزواج ينجب أولاداً أبراراً، يحب العمل، لأنه بالعمل يكسب المال وبالمال يرقى إلى الله عزّ وجل، دائماً الدنيا مطلوبةٌ لغيرها لا لذاتها، فإذا طلبتها لذاتها فقد حبط العمل .
وقال: " قليلٌ مُداوَمٌ عليـه خيرٌ من كثيرٍ مملولٍ منه ", أي اجعل أعمالك دائمةً، ولو أنها قليلة، فإن هذا الدوام يعطيك الثقة، ويعطيك تراكمًا، ويعطيك ثباتًا، ويعطيك رقيًّا، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ، وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ".
يقول هذا الإمام الجليل: " الناس أعداءُ ما جهلوا ", الناس العوام أعداء ما جهلوا، وهذا يسمونه مبدأَ العطالة، فالجسم المتحرك يرفض الوقوف والسكون، والجسم الساكن يرفض التحرك، فكل إنسان هبط مستواه عن المستوى الإنساني إلى مستوى الجماد يرفض الجديد، يرفض أنْ يصغيَ لدعوةٍ إلى الله عزَّ وجل، فيقول: هكذا نشأنا، هكذا رُبِّينَا، هكذا نحن، هكذا عاداتنا، هذا كلام الجُهَّال, الذي يقول هذا الكلام هبط إلى مستوى الجماد، أي هذا مبدؤه، مبدأ العطالة، إذا كان ساكناً يرفض الحركة، وإنْ كان متحركًا يرفض السكون، أما المؤمن فقد جاءته رسالة من الله عزَّ وجل، يقرؤها، والقرآن رسالة الله للبشر جميعهم. فهذا الذي يعادي ما يجهل، أحمقُ كبير، مغرورٌ خطير، الناس أعداء ما جهلوا، أصغِ، ولا تكنْ كالذي يحكم على الأمورِ مسبقاً من دون فحص، من دون درس، من دون تأمُّل، من دون دراسة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.
ويقول هذا الإمام الجليل: "اذكروا انقطاع اللذات، وبقاء التبعات", الموت يقطع اللذات، الطعام انتهى زمنه، هناك ولائم فخمة جداً، شيء لذيذ جداً وطيب، لذة الطعام تنتهي عند الموت ، لذة الزواج تنتهي عند الموت، لذة العلو في الأرض تنتهي عند الموت، كل هذه اللذات تنتهي عـند المـوت، ما الذي يبـقى؟ المسؤوليات. هذا المال, من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ لماذا فعلت؟ لماذا تركت؟ لماذا وصلت؟ لماذا قطعت؟ لماذا رضيت؟ لماذا غضبت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟
قال هذا الصحابي الجليل الإمام عليٌ كرم الله وجهه: " الزهد كلّه بين كلمتين من القرآن الكريم ، قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم", قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,: "لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ" .
قال:" إن أعظم الحسرات يوم القيامة، حسرة رجلٍ كسب مالاً في غير طاعة الله، فورثه رجلٌ أنفقه في طاعة الله، فدخل به الجنة، ودخل الأول به النار ", شيء مخيف يعمل خمسًا وخمسين سنة، يجمع ثروة طائلة، كلها مِن مصادر مشبوهة بالحرام، والكذب، والغش، والخداع ، ويموت ويذهب إلى جهنم، ثم يأتي الوريثُ فيأخذ هذا المال جاهزًا، ينفقه في طاعة الله فيدخل به الجنة، هذا أندم إنسان، وأندمُ الناسِ رجلاً دخل بعلمه الناس الجنة ودخل هو بعلمه النار.