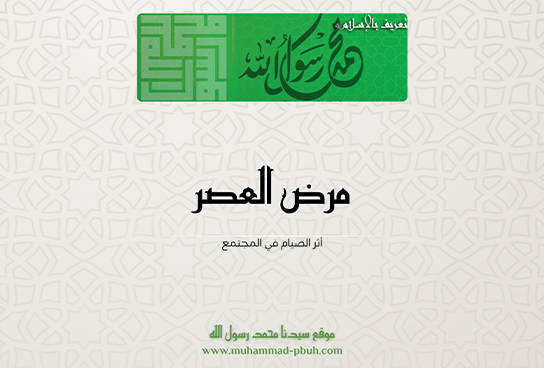الخير لا ينقطع:
أيها الإخوة المؤمنون، مع سير التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والتابعيّ اليوم هو رجاء بن حيوه،
وقد قال مسلمة بن عبد الملك: إن في كنده لثلاثة رجال، ينزل الله بهم الغيث، وينصر بهم على الأعداء، أحدهم رجاء بن حيوه
على كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة..
باب الخير مفتوح، وفضل الله عميم، لا يُحد لا بزمان ولا بمكان، ولا بأمة ولا بقرن، ولا بجيل، وإنّ الله هو هو، وعطاؤه مبذول، ورحمته واسعة، والطريق إليه سالك، وثمن الجنة معروف.
هذا يؤكد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ
أصله ونشأته:
فمن هو هذا التابعي؟.
هذا رجل وُلِد في بيسان من أرض فلسطين، وكانت ولادته في أواخر خلافة عثمان بن عفان، أو نحواً من ذلك، وكان ينتمي إلى قبيلة كندة العربية، وعلى هذا فرجاء بن حيوة فلسطيني الوطن، عربي الأرومة، كندي العشيرة.
وقد نشأ الفتى الكندي في طاعة الله، ودائماً وأبداً أؤكد لكم، مَن لم تكن له بداية محرقة، لم تكن له نهاية مشرقة
ولا أفرح حينما أنظر إلى الإخوة الكرام فرحي حينما أرى شاباً ناشئاً في طاعة الله، فالخير يتراكم، والقناعات تتراكم، والإيمان يتراكم، فإذا كان في هذه السن ملتزمًا مطبقًا منيبًا، تائبًا، فكيف إذا رأيته في الأربعين، وفي الخمسين، فالزمن لصالح المؤمن، يزيده تألقاً وعلماً، ويزيده هيبةً ومكانة، ويزيده قرباً مِن الجنة، فلذلك ما من تابعي كما ترون، إلا وقد نشأ في طاعة الله النشأة المبكرة.
نشأ هذا الفتى الكندي في طاعة الله منذ حداثة سنه، فأحبه الله، وحبَّبه إلى خلقه.
بالمناسبة، محبة الله تتجسد بمحبة الخلق، وإذا أبغض اللهُ الإنسانَ لانحرافه ومعصيته، ألقى بغضه في قلوب العباد،فلا أحد يحبه، أما إذا كان قوياً مُدِح في وجهه، أما العبرة فبما يُقال في غيبته، فلا تأبه، ولا تلقي بالاً، ولا تهتمّ لِمَا يقال في حضرتك، أنت أحد رجلين، إما أن يخافك الناس، وإما أن يرجوا ما عندك، وفي الحالتين يتملقونك، ويكيلون لك المديح جزافاً، ويمدحونك بما ليس فيك، لكن الذي يُعوَّل عليه ما يُقال في غيبتك.
إقباله على العلم:
أقبل هذا الفتى على العلم من نعومة أظفاره، فوجد العلم فؤاده غضاً طرياً خالياً، فتمكن منه، واستقر فيه.
أنت كالوعاء، وقد قيل:
أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَى فَصَادَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَــنَّا
***
الإنسان إذا طلب العلم في وقت مبكر، يكون وعاؤه فارغًا، فحينما يُلقى العلم فيه يتمكن، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر، أما إذا امتلأ بمشاغل الدنيا، وشهواتها، وطموحاتها، فلم يعُد العلمُ يصادف محلاًّ فيه.
لم يَعُد ثمة محلٌّ شاغر، فالقلب إذا امتلأ بمحبة الدنيا لم يبقَ شيء لمحبة الله، والله عز وجل قال في القرآن الكريم: ( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ)
فهو قلب واحد.. هذه نقطة دقيقة، هذا القلب وعاء، إذا كان فارغاً مما سوى الله امتلأ كله بمعرفة الله، وإذا كان معبَّأ إلى ثلاثة أرباعه من الدنيا لم يبق منه إلاّ الربع.
فالبطولة كما قال الله عز وجل: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)
وجد العلم فؤاده غضاً طرياً خالياً، فتمكن منه، واستقر فيه، وجعل همَّه الأكبر التضلعَ من كتاب الله.
أقول هذا الكلام كثيراً: فَضُل كلامِ اللهِ على خلقه كفضل الله على خلقه، وأيّ كتاب تقرأه فمؤلِّفه بشر محدود، لكنك إذا قرأت كتاب الله عز وجل فقد قرأتَ كتاب خالق البشر.
فكان همه الأول التمكن من كتاب الله، والتزودَ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تصور إنسانًا وعاؤه ممتلئ بالقرآن والسنة، هذا كيفما تكلم، وكيفما تحرك لا ينطق إلا بالحق، ولا يتكلم إلا بالحكمة، ولا يقف إلا الموقف الكامل.
أتيح لهذا التابعي الجليل أن يأخذ عن طائفة كبيرة من جلّة علماء الصحابة.
هذه الفكرة توقفنا عند حقيقة، وهي أن العلم لا يؤخذ إلا من الرجال، ولو أمكن أن يؤخذ العلم من الكتب مباشرةً لاستغنت وزارات التربية في العالم عن ألوف ألوف المعلمين، ولو أمكن أن يؤخذ العلم من كتاب فقط دون معلم، هذه حقيقة ثابتة،
وقد قيل: العلم لا يؤخذ إلا عن طريق عالم ورع متحقق، فالورع صفة نفسية، والتحقق صفة فكرية، متحقق من علمه، ورع في سلوكه، هذا هو السبيل.
أخذ عن أبي سعيد الخدري، وأبي الدرداء، وأبي أمامة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن عمر بن العاص، وغيرهم، فكان هؤلاء الأساتذة العلماء الأجلاء مصابيح هداية، ومشاعل عرفان، وضع هذا الفتى التابعي لنفسه دستوراً ظل يلتزمه طوال حياته،
فكان يقول: ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان..
الإسلام انصياع لله، لكن إذا كان انصياعًا من دون إيمان فلا يستمر. ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان يزينه التُّقى وما أحسن التقى يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرفق
هذا منهج هذا التابعي، إسلام، وإيمان، وتقوى، وعلم، وعمل، ورفق.
عمله كوزير:
لكن الشيء الذي يلفت النظر في سيرة هذا التابعي هو أنه كان وزيراً لعدد كبير من خلفاء بني أمية، وقد تعجبون كيف وفَّق بين مقتضيات منصبه، وبين كونه من التابعين الأجلاء الورعين العاملين.
كان لهذا التابعي صلة متينة بسليمان بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز فاقت صلاته بمَن سبقه من الخلفاء، أدناه من قلوب الخلفاء رجاحةُ عقله، وصدقُ لهجته، وإخلاصُ نيته، وحكمتُه في معالجة الأمور.
أيها الإخوة الأكارم، الإنسان يوفَّق إلى أقصى درجة حينما يكون إلى جانبه من يُعِينُه على الخير، ويدُلُّه عليه، دعاء رسول الله لأمراء المسلمين: اللهم هيئْ لهم بطانة خير تدلهم إليه، وتعينهم عليه.
وأنت كإنسان حاول أن يكون لك مستشار، يدلُّك على الخير، ويعينك عليه، وإياك وبطانة السوء، الذين اشتروا دنياك بدينهم، ورضاك بسخط ربهم.
أحياناً الإنسان يكون مدير مدرسة، عنده ثلاثون أو أربعون مدرسًا، مدير مشفى عنده ثلاثون أو أربعون طبيبًا، ترى واحداً تقرَّب منه زيادة، هذا الشخص سنُسَمِّيهِ مستشارًا، سنُسَمِّيهِ من البطانة، ومن الحاشية، هناك شخص بطانة سوء يوغر صدره دائماً على بقية الناس، يدلّه دائماً على عملٍ يؤذي المصلحة يقول له: هذه أقوى لمركزك، فلان اعمل معه كذا، فلان تكلم عليك بغيابك كذا، فهذا الرجل من بطانة السوء.
أحياناً يكون الإنسان مدير معمل، مدير مشفى، مدير مدرسة، رئيس دائرة صغيرة، وحوله موظفون، هذه هي الحاشية، فاحذَرْ أن يكون أقرب الناس إليك رجلَ سوء.
سيدنا عمر بن عبد العزيز عيَّن مستشارًا عالمًا جليلاً، اسمه عمر بن مزاحم، قال له:
يا عمر كنْ إلى جانبي دائماً، وراقبْ ما أفعل، وانظرْ ما أقول، فإنْ رأيتني ضَللتُ فأمسكني من تلابيبي، وهُزَّني هزًّا شديداً، وقل لي: اتَّقِ اللَّهَ يا عمر، فإنك ستموت.
والله لو كُشِف الغطاء لرأيت الذي ينتقدك، وينصحك، ولو كان قاسياً، لرأيتَ فضله عليك لا حدود له، فالذي ينتقدك يرفعك، والذي يمدحك بما ليس فيك يضعك، هكذا قال سيدنا عمر قال: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي
وطِّن نفسَك على سماع النقد، وطِّن نفسك على سماع النصيحة، ولو كانت قاسية، لأنها تنطلق من حبٍّ، ومن حرص، ومن غيرة، ولا تعوِّد نفسك على سماع المديح، مثل الجربان، يريد من يحكُّ له دائماً.
لا توطِّن نفسك على سماع المديح، اطلب النقد، واطلب المآخذ، واطلب المثالب، واطلب السقطات، واطلب الهنات، وتلافاها، فإنّك سترقى بها بسرعة، أمّا إنْ عوَّدتَ نفسك على سماع المديح والثناء لم تَعُدْ حينئذٍ تقبل أن يذمك أحد أبداً، ولا ترضى، بل تريد تحطيمه، لأنّك تعوّدتَ على المديح، وصار بك إدمان مثل المخدرات، فوطِّن نفسك على سماع النقد، وعلى سماع النصيحة، وعلى سماع المآخذ، وبهذا ترقى.
اسمع كلام سيدنا عمر: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي
أعدائي لهم فضل عليَّ ومِنّة، فلا أعدم الله لي الأعادي، ذكروني بالعيوب فبرئت منها، فالأبطال دائماً يصغون إلى النقد باهتمام، ويشكرون، ويثنون.
طريق القمة صعب، ومع أنه صعب فقد تصل إلى القمة، في عملك، في دراستك، في تدريسك، في تجارتك، في زعامتك، في قيادتك، ممكن، ولكن بعد أن تصل إلى هذه القمة البطولة ليس أنك وصلت إليها، لكنّ البطولة أن تبقى فهيا، لأن في القمة آلاف الطرق التي توصلك إلى الحضيض، فإذا كان طريق الصعود طريقًا وعرًا فطريق النزول كله سيراميك مع صابون، لأنّ الغرور يهلكك، ورفضُ النقد يهلكُك، والاعتداد بالرأي يهلكك، لذلك البطولة أن تبقى في القمة، وهذا يحتاج إلى معارضة، وإلى نصيحة، وإلى بطانة خير تدلُك على الخير، وتعينك عليه.
فهذا التابعي وزير لخلفاء بني أمية:
أولاً: دعاهم إلى الخير ودلّهم عليه.
ثانياً: ثنّاهم عن الشر، وأوصد دونهم أبوابه.
ثالثاً: أراهم الحق، وزيّن لهم اتِّباعه، وبصّرهم بالباطل، وكره إليهم إتيانه، ونصح لله، وللرسول، ولأئمة المسلمين وعامتهم.
فالمفروض أن يكون للإنسان اتجاه، يكون عنده كلمة (لا أوافق)، يكون عنده كلمة (لا أرضى بهذا)، يكون عنده كلمة (اعتراض) حتى تكون له شخصية.
دعاهم إلى الخير ودلّهم عليه، وثنّاهم عن الشر، وأوصد دونهم أبوابه، وأراهم الحق وزيَّنه لهم، وبصّرهم بالباطل، وكرَّه لهم إتيانه، ونصح لله ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.
له قصة مع سليمان بن عبد الملك، يرويها ويقول:
إني لواقف مع سليمان بن عبد الملك في جموع من الناس، إذ رأيت رجلاً يتجه نحونا وسط الزحام، وكان حسنَ الصورة، جليلَ الهيئة، فما زال يشق الصفوفَ، وأنا ما أشكُّ أنَّه يروم الخليفة حتى حاذاني.
هو ظن أن الرجل الوقور يتَّجه نحو الخليفة، فإذا به يتّجه نحوي، ثم وقف إلى جانبي، وحيَّاني،
وقال: يا رجاء
والخليفة يقف بجانبه
قال له: يا رجاء إنك قد ابتليت بهذا الرجل، وأشار إلى الخليفة، وإنّ في القرب منه الخير الكثير والشر الكثير، فاجعل قربَك منه خيراً لك وله وللناس، واعلمْ يا رجاء أنه مَن كانت له منزلة من السلطان فرفع إليه حاجة امرئٍ ضعيف لا يستطيع رفعها لقِيَ الله جل وعز يوم يلقاه، وقد ثبَّتَ قدمَيْه للحساب.
أحياناً يكون للرجل صديق وهو مدير عام مؤسسة، إنسان بمنصب حساس، هذه العلاقة أنت مُحاسب عنها يوم القيامة، يا ترى هل يوجد رجل مظلوم له مشكلة عند هذا الرجل العظيم، وأنت صديقه، إذا كانت هناك فائدة تجنيها من هذه العلاقة أنْ تنقل لهذا الإنسان الذي بيده الأمر ظُلامة ممَّن لا يستطيع نقلها إليه.
ليس هناك مَن لا أصحاب له، ولا أصدقاء له، أو قرابات، أنت تعرف أناس مظلومين، والعلماء ما كانوا يجيزون لأنفسهم التقرُّب مِنَ الأمراء إلا من أجل رفع ظلامات المسلمين إليهم.
إذا كان لك علاقة مع إنسان قوي، إنسان بيده الأمر، فهذه العلاقة يجب أن توظفها في سبيل إنصاف المظلومين، لا أن تحدثه بعلاقات ومودات وسهرات فقط من أجل أن تشعر بالأمن، أنا فلان صديقي، تشعر أنه لا أحد يقترب منك، أنت لم تستغلَّ هذه العلاقة في خدمة الناس، ولم توظفها لخدمة الحق، إنما استخدمتها لتوهِمَ نفسَك أنك في أمن.
قال له: واذكر يا رجاء أنه مَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، واعلم يا رجاء أنّ مِن أحبِّ الأعمال إلى الله عز وجل إدخالَ الفرح على قلوب الناس.
مرةً قال لي طبيب كلمة كَبُر بها في نظري كثيراً، قال: أنا ذقتُ كل ملاذ الدنيا، لكن حينما أجري عملية ناجحة لإنسان، ويشعر أنها نجحت، ويبتسم، أشعر بسعادة لا توصف.
العظماء أيها الإخوة، لا يسعدهم إلا أن يسعد الناس بهم، أما الصغراء فما دام بيتُهم فيه كل شيء، وطعامهم جيد، وأموالهم كثيرة، فعلى الدنيا السلام، لكنَّ عظماء الناس يسعدون بإسعاد الآخرين، ويسعدون إذا رأوا البسمة على قلوب الناس.
زرت أخًا من إخواننا الكرام، معه مرض عضال، ورأيت أولاده في كآبة، هذا الأخ الكريم تلقى هاتفًا من إنسان قال له: غداً قابل الطبيب الفلاني، والعملية حسابُها مغطَّى، لم يعرف إلى الآن مَن أخبره، ذهب إلى الطبيب، وقال له: العملية جاهزة متى تحب، قال: بعد يومين، زرته بعد حين فرأيت أولاده يقفزون من الفرح، قلت: هذا الذي دفع ثلاثمائة ألف أدخل الفرح على هذه الأسرة، الأب والزوجة والأولاد، أليس ذلك أفضل من أن يعمل عرسًا في فندق، ثم يدفع عشرين مليونًا، أو عشرة ملايين، أو مليون.. لا أحد يعرف مِن أين السعادة.. السعادة بإسعاد الناس، أنْ تعيش في قلوبهم، أن ترى البسمة على أفواه الصغار.. لذلك كلمة لا أنساها أبداً، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك.
هناك إنسان كله خيرات، كله معونة، هناك شخص بنى نفسه على أنقاض الناس، وعلى أخذِ ما في أيديهم، وعلى بثِّ الرعب في قلوبهم، هذا أشقى إنسان، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك، وفيما وظفك اللهُ عنده..
قال أمير المؤمنين عن أحد أحدهم: واللهِ لئن أمكنني الله منه لأفعلنّ ولأفعلنّ ولأضعنَّ السيف في عنقه،
ولم يمض وقتٌ طويل حتى أمكنه الله من الرجل، وسيقَ إليه سوقاً، فلما وقعت عيناه عليه كاد يتميز من الغيظ، وهمَّ أن ينفذ وعيدَه بقتله، وكان رجاء جالسًا،
فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ الله عز وجل قد صنع لك ما تحبّ مِن القدرة عليه، فاصنعْ لله ما يحبُّ من العفو
استجاب الله لك الدعاء، ونفّذ رغبتك، وجعله بين يديك، فالآن قابلْ هذا الإكرامَ من الله أنه مكنك منه، قابِلْه بما يحبّ اللهُ عز وجل مِن العفو عنه، فسكنتْ نفسُ الخليفة، وسكتَ عنه الغضبُ، وعفا عن الرجل، وأطلق سراحه، وأحسن إليه.
لا تكنْ إنسانًا يسبِّب الشر لإنسان ليس منا من فرق
اجمع، وقَرِّبْ بين الناس، والتمسْ لهم العذر، ودافعْ عنهم يرضَ عنك الله، ولا تَبْنِ مجدَك على أنقاض الآخرين، أشخاص كثر يرتفعون على أنقاض أناس آخرين، فيحطِّم إنسانًا، ويعلو هو، يحطم جهةً ويعلو هو، والإنسان هو هو، ولو اختلف الزمان.
سنة إحدى وتسعين حجّ الوليد بن عبد الملك وبصحبته رجاء، فلما بلغا المدينة زارا المسجد النبوي الشريف، يرافقهما عمر بن عبد العزيز، وقد رغِب الخليفة أن ينظر إلى الحرم النبوي نظرة أناة ورَوِيَّة، إذْ كان عقَدَ العزمَ توسعَتَه حتى يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع، الآن يسع الحرم النبوي ما يزيد عن مليون مصلٍّ.
كانت الرغبة أن يوسِّعه إلى مائتي ذراع بمائتي ذراع، فإذا الرجل زار الحرم النبوي الآن يرى أعمدة بيضاء هي الروضة، وبعدها عمودين أخضرين مكتوب هذا حدود المسجد النبوي، حتى تعرف حجم المسجد النبوي عندما كان رسول الله فيه، هؤلاء فتحوا العالم، ونحن مليار ومائتا مليون!..
فأُخرِجَ الناسُ من المسجد ليتمكّن الخليفة من تأمله هكذا صدر الأمر، ولم يبق في المسجد غيرُ سعيد بن المسيب هو رجل من التابعين، إذ لم يجرؤ الحرس على إخراجه له هيبته،
فأرسل عمر بن عبد العزيز إليه، وكان يومئذ والياً على المدينة، مَن يقول له:لو خرجتَ من المسجد كما خرج الناس
إذا أمكن
فقال سعيد بن المسيب: لا أغادر المسجد إلا في الوقت الذي اعتدتُ أن أغادره فيه كل يوم،
فقيل له: لو قمتَ فسلمتَ على أمير المؤمنين
طيِّب قفْ وسلِّم عليه
فقال: إنما جئت إلى هنا لأقوم للهِ رب العالمين، هذا بيت الله..
فلما عرف عمر بن عبد العزيز ما دار بين رسوله وسعيد بن المسيب جعل يعدل بالخليفة عن المكان الذي فيه سعيد
أخذه إلى الطرف الآخر حتى لا تنشأ مشكلة
وأخذ رجاء يشاغله بالكلام لِمَا كانا يعلمان من شدة عنفوان الخليفة
الخليفة عنده عنفوان شديد، وهذا الرجل لا يخرج من المسجد الآن، ولا يقف للسلام
فقال لهما الوليد: مَن ذلك الشيخ؟ أليس هو سعيد بن المسيب؟
قالا: بلى يا أمير المؤمنين، وطفِقا يصِفَانِ من دينه وعلمه وفضله وتقواه
حتى يغطوا على بقائه وجلوسه
ثم قالا: لو عِلَم بمكان أمير المؤمنين لقام إليه، وسلّم عليه، ولكنه ضعيف البصر،
فقال الوليد: إني لأعلم من حاله مثلما تذكران، وهو أحقُّ أن نأتيه ونسلِّم عليه،
ثم دار في المسجد حتى أتاه، ووقف عليه وحيّاه، وقال: كيف الشيخ؟ فلم ينهض الشيخ من مكانه،
وقال: بنعمة وله الحمد والمنة، قال له: فكيف أمير المؤمنين وفَّقه الله لما يحبّه ويرضاه،
فانصرف الوليد، وهو يقول: هذا بقيّة الناس، هذه بقيّة السلف الصالح.
والخلفاء كانوا أتقياء.
ولما أفْضَت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك كان لرجاء بن حيوه عنده شأن يفوق شأنه عند سابقه، الآن القصة دقيقة جداً، أكبر هذه القصص أنه حدّث رجاء فقال:
لما كان أول يوم جمعة من شهر صفر عام تسعة وتسعين، كنا مع أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك بدابق وكان قد أرسل جيشاً لجب إلى القسطنطينية، بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك، ومعه ابنه داود، وطائفة كبيرة من آل بيته، وقد آل على ألاّ يبرح مرج دابق حتى يفتح الله عليه القسطنطينية، أو يموت.
سليمان عنده رغبة أن تُفتح على يديه القسطنطينية، وكانت معقل الروم، فلما اقترب موعد صلاة الجمعة توضأ الخليفة فأحسن الوضوء ثم لبس عمامة خضراء، ونظر في المرآة نظرة معجب بنفسه، مزهواً بشبابه، وكان في نحو الأربعين من عمره، ثم خرج ليصلي بالناس الجمعة، فلم يرجع من المسجد إلا وهو موعوك
أصابته الحمى
ثم أخذ يثقل عليه المرض يوماً بعد يوم، وقد سألني أن أظلّ قريباً منه، فدخلتُ عليه ذات يوم فوجدتُه يكتب كتاباً،
فقلت: ما يصنع أمير المؤمنين؟
قال: أكتب كتاباً أعهد به إلى ابني أيوب بالخلافة من بعدي،
فقلت يا أمير المؤمنين
اسمعوا دور الناصح، دور بطانة الخير التي تدلّ على الخير، وتعين عليه
قال: يا أمير المؤمنين إنّ ممّا يحفظ الخليفة في قبره، ويبرئ ذمته عند ربه أن يستخلِف على الناس الرجل الصالح، وإن ابنَك أيوب غلامٌ لم يبلغ الحلم بعد، ولم يتبين صلاحه من طلاحه، فتراجع،
وقال: إنه كتاب كتبته، وأنا أريد أن أستخير الله فيه، ولم أعزم عليه
قال: لم أقرر بعد
ثم مزق الكتاب.
التغت خلافة أيوب بهذه النصيحة.
ومكث بعد ذلك يوماً أو يومين ثم دعاني، وقال: يا رجاء ما رأيك في ولدي داود،
فقلت: هو غائب مع جيوش المسلمين في قسطنطينية، وأنت لا تدري الآن أحيٌّ هو أم ميت،
فقال: فمَن ترى إذن يا رجاء،
قلت: الرأي رأي أمير المؤمنين، وكنت أريد أن أنظر فيَمن يذكرهم لكي أستبعدهم واحداً واحداً حتى أصل إلى عمر بن عبد العزيز.
يعني كل أعمال سيدنا عمر بصحيفة رجاء، هو الذي أقنع الخليفة باختياره.
فقال: كيف ترى عمر بن عبد العزيز،
قلت: واللهِ يا أمير المؤمنين مَا علمته إلا فاضلاً كاملاً عاقلاً بيناً،
قال: صدقت، إنه والله لكذلك، ولكنني إن ولّيته، وأغفلت أولاد عبد الملك لتكوننّ فتنة، ولا يتركونه يلي عليهم أبداً،
قلت: أشرك معه واحداً منه، واجعله بعده،
قال: واللهِ لقد أصبت، فإنّ ذلك مما يسكنهم، ويجعلهم يرضونه، ثم أخذ الكتاب، وكتب بيده:
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز، إني ولّيته الخلافة من بعدي، وجعلتها من بعده ليزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا، واتقوا الله، ولا تختلفوا فيطمع بكم الطامعون، ثم ختم الكتاب، وناولني إياه، ثم أرسل إلى كعب بن حازم صاحب الشرطة،
وقال: ادع آل بيتي فليجتمعوا، وأعلِمْهُم أن الكتاب الذي في يد رجاء هو كتابي، ومُرْهُم أن يبايعوا لمَن فيه،
قال رجاء: فلما اجتمعوا قلت لهم: هذا كتاب أمير المؤمنين، قد عهد فيه للخليفة من بعده، وقد أمرني أن آخذ منكم البيعة لمَن ولاه (ولكن لم يعرفوا من)،
فقالوا: سمعاً لأمر أمير المؤمنين، وطاعة لخليفته من بعده، وطلبوا أن أستأذن لهم على أمير المؤمنين للسلام عليه،
فقلت: نعم،
فلما دخلوا عليه قال لهم: إن هذا الكتاب الذي في يد رجاء هو كتابي، وفيه عهدي للخليفة من بعدي، فاسمعوا وأطيعوا لمَن ولّيتُ، وبايِعوا لمَن سمّيت في هذا الكتاب، فطفِقوا يبايعون رجلاً رجلاً،
ثم خرجتُ بالكتاب مختوماً لا يعلم أحد من الخلق ما فيه غيري وغير أمير المؤمنين، فلما تفرّق الناس جاءني عمر بن عبد العزيز،
فقال: يا أبا المقدام، إن أمير المؤمنين رجلٌ حسن الظن بي، وكان يوليني من كريم بره وصافي وداده الشيءَ الكثير، وأنا أخشى أن يكون قد أسندَ إليّ مِن هذا الأمر شيئاً، فأنشدك الله، وأسألك بحرمتي ومودتي، أن تعلمني إنْ كان في الكتاب شيءٌ يخصني حتى أستعفيه من ذلك قبل فوات الفرصة،
فقلت له: لا واللهِ ما أنا بمخبرك حرفاً واحداً ممّا سألت عنه، فتركني وتولى عني وهو غضبان.
ثم جاءني هشام بن عبد الملك،
قال: يا أبا المقدام إن لي عندك حرمة ومودة قديمة، وإن لك عندي شكراً جزيلاً فأعلمني بما في كتاب أمير المؤمنين، فإن كان هذا الأمر إليّ سكت، وإن كان لغيري تكلمتُ، فليس مثلي من يُنحى عن هذا الأمر، (موقف معاكس تماماً)، ولك عهدُ الله ألاّ أذكر اسمك أبداً،
فقلت: لا والله، لا أخبرك بحرف واحد ممّا في الكتاب،
فانصرف وهو يضرب كفاً بكفٍّ ويقول: لمَن يكون هذا الأمر إذا أنا نُحّيتُ عنه، أتخرج الخلافة من بني عبد الملك، واللهِ إني لعيب أولاد عبد الملك.
ثم دخلت على سليمان بن عبد الملك، فإذا هو يجود بروحه، فجعلتُ إذ أخذته السكرةُ من سكرات الموت أحرِّفه نحو القبلة، فكان يقول لي وهو يشهق: لم يأنِ ذلك بعد يا رجاء، حتى فعلت ذلك مرتين، فلما كانت الثالثة قال: الآن يا رجاء إن كنتَ تريد أن تفعل شيئاً فافعله (يعني انتهى الأمر) أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فحرفته نحو القبلة، فما لبث أن أسلم روحه لله، عند ذلك أغمضتُ عينيه، وسجّيته بقطيفة خضراء، وأغلقتُ الباب عليه، وخرجتُ، فأرسلتْ إليَّ زوجتُه تسألني عنه، وتطلب مني أن أخبرها عن حاله، فقلت لها، شققتُ عنه الباب وقلتُ لرسولها، انظر إليه، لقد نام الساعة بعد سهر طويل، فدعوه، فرجع فأخبرها، فقبلت ذلك، وأيقنت أنه نائم،
ثم أحكمتْ إغلاق الباب وأجلستْ عنده حارساً أثِقُ به، وأوصيته ألاّ يتزحزح عن مكانه حتى أعود، وألاّ يُدخل على الخليفة أحداً أبداً، كائناً من كان، ومضيتُ، فلقيني الناس، وقالوا: كيف أمير المؤمنين؟
قلت: لم يكن منذ مرض أسكنَ منه الآن، ولا أهدأ،
فقالوا: الحمد لله،
ثم أرسلتُ إلى كعب بن حازم صاحب الشرطة، فجمع أهلَ بيت أمير المؤمنين جميعاً في مسجد دابق،
فقلت: بايعوا لمَن في كتاب أمير المؤمنين،
قالوا: قد بايعنا مرةً أنبايع أخرى مرةً ثانية،
فقلت: هذا أمر أمير المؤمنين، بايعوا على ما أمر به، ولمَن سمّى في هذا الكتاب المختوم، فبايعوا رجلاً رجلاً، فلما رأيت أني قد أحكمت الأمر قلت: إن صاحبَكم قد مات، وإنّا لله وإنا إليه راجعون، وقرأت عليهم الكتاب، فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز، نادى هشام بن عبد الملك: لا نبايعه أبداً، فقلت: إذاً والله تُضربُ عنقُك، فقام يجرّ رجليه، فلما انتهى إلى عمر قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو يسترجع لنصيب الخلافة إلى عمر دونه، ودون إخوته من أولاد عبد الملك، وقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان يسترجع لمصير الخلافة إليه على كره منه.
فكانت بيعة جَدَّد اللهُ فيها للإسلام شبابه، ورفع للدين منارَه، فطوبى لخليفة المسلمين على هذه التولية، وطوبى لرجاء على هذه النصيحة.
هذا رجل من التابعين، كان وزيراً لعدد من خلفاء بني أمية، وكان ناصحاً أميناً من بطانة الخير، يدل على الخير ويعين عليه.