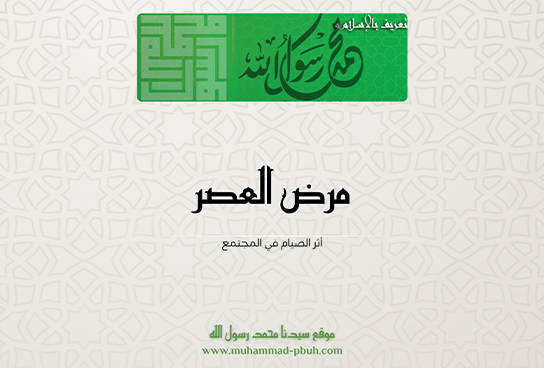أيها الإخوة الكرام، مع سير التابعين رضوان الله عليهم أجمعين، والتابعي اليوم هو سعيد بن جبير،
قال عنه الإمامُ أحمد بن حنبل: لقد قتل سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا ومحتاج إلى علمه.
قصة هذا التابعي تثير تساؤلات كثيرة، لكن أنا أضع بين أيديكم دقائقها وتفاصيلها، وبإمكانكم أن تستنبطوا أشياء كثيرة، أحد أكبر الأشياء التي ينبغي أن تستنبط من هذه القصة، أن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ودار ابتلاء. ( يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ)
الإنسان حينما يوطِّن نفسه على أن هذه الدنيا دار ابتلاء، ويرضى بكل شيء،
وصفه:
فكان هذا التابعي فتًى وفيق الجسم، مكتمل الخلق، متدفقاً حيوية ونشاطاً، وكان ذكي الفؤاد، حاد الفطنة، نزّاعاً إلى المكارم، متأثماً من المحارم، شديد الخوف أن يقع في الإثم، لكنه كان أسود اللون، شعره مفلفل، لأن أصله حبشي، هذا الأصل الحبشي، ولونه الأسود، وشعره المفلفل، وأنفه الأفطس، ما كان لينال من مكانته الرفيعة بين المسلمين، هذا مجتمع المسلمين، مجتمع المقياس الواحد، مقياس التقوى. ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)
وما لم يكن هذا المقياس سائداً في المجتمع فالمجتمع متخلف، وأيّة قيمة يوزن بها الإنسان غير قيمة العلم والعمل والتقوى، فهذا دليل تخلف المجتمع،
تمسكه بالعلم والتقوى:
وكان سعيد بن جبير حديثَ السن، حبشي الأصل، عربي الولاء، أدرك أن العلم وحده هو الذي يرفعه، وأن التقى وحدها هي التي تكرمه، وتبلغه الجنة،
لذلك قالوا: تعلموا العلم، فإن كنتم سادةً فُقْتُمْ، وإن كنتم وسطاً سُدْتُم، وإن كنْتُم سوقةً عِشْتُم.
لو فرضنا إنسانًا والده شخص عاديّ، فقير لا في مال، ولا في جاه، يا ترى طريق المجد مفتوح أمامه على مصراعيه؟ من خلال العلم، فأي إنسان لو كان والده من الطبقة الدنِيا في المجتمع، لو كان فقير مدقعًا، من الطبقة التي لا يُؤْبَهُ لها، لكنه إذا سلك طريق العلم تألّق نجمه، وعلا اسمُه، وأصبح يشار إليه بالبنان.
أدرك هذا الفتى أن العلم هو الطريق الوحيد إلى الرفعة، وأن التقى هي الطريق الوحيدة إلى الجنة، فجعل التقى عن يمينه، والعلم عن شماله، وشدّ عليهما بكلتا يديه، وانطلق يقطع بهما رحلة الحياة، غير وَانٍ ولا متمهل، هو أساساً سبب سعادة الإنسان الكبرى أن يتخذ قراراً ناجحاً،
فمنذ نعومة أظفاره كان الناس يرونه إمَّا عاكفاً على كتاب يتعلم، أو صافًّا في محراب يتعبد، فهو بين طلب العلم والعبادة، إما في حالة تعلم، أو في حالة تعبد، والتعلم غذاء العقل، والتعبد غذاء القلب، والإنسان عقل وقلب وجسم، لكن الجسم يستوي فيه مع الحيوان، الجسم غذاؤه الطعام والشراب، والعقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه التعبد، دَعُونا من الجسم، لأنه قاسم مشترك مع كل المخلوقات، وبقي الإنسانُ عقلاً وقلبًا، فالذكر والعبادة والصلاة والتلاوة تغذِّي القلب، والعقل العلم والفهم والدليل والحجة والإطلاع والمطالعة والسماع والقراءة تغذيه أيضًا، فاتخذ قرارًا حكيمًا طريقه للمجد، العلم والتقوى، العلم والعمل، هذا مقياس الله عزوجل.
تعلمه وتعليمه:
أخذ هذا الفتى العلم عن طائفة مِن جلّة الصحابة، مِن أمثال أبي سعيد الخدري، وعدي بن حاتم الطائي، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة الدوسي، وعبد الله بن عمر، وعائشة أم المؤمنين، رَضِي اللَّه تعالى عَنْهم أجمعين، لكن أستاذه الأكبر، ومعلمه الأعظم، كان عبد الله بن عباس، حبر الأمة، وبَحر علمها الزاخر،
لزِم سعيدُ بن جبير عبدَ الله بن عباس لزومَ الظلِّ لصاحبه، فأخذ عنه القرآن وتفسيره، والحديث وغريبه، وتفقّه على يديه في الدين، وتعلّم منه التأويل ودرس عليه اللغة، فتمّكن منها أعظم تمكين، حتى غدا الآن - دققوا - وما على ظهر الأرض أحد من أهل زمانه إلا وهو محتاج إلى علمه، لقد بلغ القمة، ثم طاف في ديار المسلمين بحثاً عن المعرفة ما شاء الله أن يطوف،
فلما اكتمل له ما أراد من العلم اتخذ الكوفة له داراً ومقاماً، وغدا إلى أهلها معلماً وإماما،
عبادته:
وكان يؤم الناس في رمضان، وكان إذا صلى منفرداً ربما قرأ السورة الطويلة من القرآن، وكان إذا مرّ بقول الله عز وجل: ( فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ)
أو مرَّ بنحوها من آيات الوعد والوعيد اقشعر جلده، وتصدع فؤاده، وهملتْ عيناه، ثم لا يزال يبدأ فيها ويعيد حتى يوشك أن يقضي نحبه، فصلاة الليل أحد أكبر مصارد سعادته، وقد دأَب على شدِّ رحاله إلى بيت الله الحرام كل عام مرتين، مرةً في رجب محرِماً بعمره، وأخرى في ذي القعدة محرِماً بحج.
وقد كان طلاب العلم والخير والبِّرِّ والنصح يتوافدون على الكوفة لينهلوا من مناهل سعيد بن جبير العذبة، ويغترفوا من هديه القويم،
فهذا يسأله عن الخشية، ما هي؟ فيجيبه: الخشية أن تخشى الله عز وجل حتى تحول خشيتك بينك وبين معاصيك،
ومَن هو الذي يخشى الله؟ هو الذي لا يعصيه، فإذا حالت الخشية بينك وبين معاصيك فأنت ممَّن يخشى الله
وإذا سئل عن الذِّكر ما هو؟ يقول: الذكر طاعة الله عز وجل، فمَن أقبل على الله، وأطاعه فقدْ ذكَره، ومَن أعرض عنه، ولم يطِعْه فليس له بذاكر، ولو بات ليلة يسبِّح ويتلو.
لقد وَضَعَ يده على جوهر الدين، فما دام هناك مخالفات ومعاصٍ، لو أمضيت ليلة بكاملها تسبح وتتلو وتقرأ، فهذا لا يعبأ به أحد، الأصل أن تؤدِّيَ الواجبات، وأن تعطيَ الحقوق،
قصته مع الحجاج:
وقد كانت الكوفة حينما اتخذها سعيد بن جبير دارَ إقامةٍ له خاضعةً للحجاج بن يوسف الثقفي، فيجب على أهل العلم أن يكونوا في معزل عن الوحول، عن وحول الأحداث اليومية، والصراعات، والأخذ والرد، لأنهم إذا اقتربوا من هذه المنطقة الخطرة ربما ضَحَّوْا بعلمهم، أو ربما قطعَ خيرهم، فالأَوْلى أن يصون أهلُ العلم علمَهم عن الابتذال،
وكان الحجاج والياً على العراق والمشرق وبلاد ما وراء النهر، وكان يتربّع حينئذٍ على ذروة سطوته وسلطانه، وذلك بعد أن قَتَلَ عبدُ الله بنُ الزبير، وقَضَى على حركته، وأخْضعَ العراقَ لسلطان بن أمية، وأخمد نيران الثورات القائمة هنا وهناك، وأعمل السيف في رقاب العباد، وأشاع الرعب في أرجاء البلاد، حتى امتلأت القلوبُ رهبةً منه، وخشيةً من بطشه، خطبته الشهيرة:
أما بعد، فإني قد رأيت رؤوساً قد أينعت، وحان قطافها، وإني لصاحبها،
له خطبة شهيرة جداً،
ونحن لا يعنينا الحجاج، لكن يعنينا أن يَحدُث تداخلٌ بين أهل العلم وأهل الحكم، ثم شاء الله أن يقع صدامٌ بين الحجاج بن يوسف الثقفي وبين عبد الرحمن بن الأشعث، أحد كبار قوّاده، فكيف حصل هذا الخلاف؟.
الآن نحن مضطرون أن ندرس جانباً ممَّا نشب مِن خلافٍ بين الحجاج وبين هذا القائد، لأنه هناك مداخلة في هذا الموضوع، بين سعيد بن جبير، وبين أحداث الخلاف بين الحجاج، وبين قائده الكبير الأشعث، أحد كبار قواده.
سيَّر الحجاجُ ابنَ الأشعث بجيش لغزو رتبيل، ملك الترك على المناطق الواقعة وراء جسستان، فغزا القائد الباسل المظفر شطراً كبيراً من بلاد رتبيل، واحتل حصوناً منيعة من ديارهم، وغنم مغانم كثيرة من مُدُنِه وقُراهُ، ثم بعث إلى الحجّاج رسلاً زفّوا له البشائر، بشائر النصر الكبير، وحملوا معهم خُمس الغنائم لتستقر في خزائن بيت مال المسلمين، وكتب له كتاباً استأذنه فيه بالتوقف عن القتال مدة من الزمن، ليختبر مداخل البلاد ومخارجها، ويقف على طبيعتها وأحوالها، قبل أن يعيد الكَرَّة في الغد، لماذا فعل هذا؟ خاف أن يتوغل في شعابها القاسية المجهولة، وخاف أن يعرض جيشه الظافر للمخاطر، فاغتاظ الحجاج منه، وأرسل إليه كتاباً يَصِفُه فيه بالجبن والخنوع، وينذره بالويل والثبور، ويهدِّده بالتنحية عن القيادة.
فلو أن الحجاج عرف أن هذا القائد الذي فتح البلاد، واحتل الحصون، وأرسل الغنائم، وقال: سأتوقف قليلاً لأختبر مداخل البلاد ومخارجها وشعابها وأوديتها، قبل أن أُقْحِم الجيشَ الظافرَ المنتصرَ في المهالك، فهذا كلام منطقي، لكن الإنسانَ حينما يصل القمّة ربما لا يرى، لأنه دائما إذا ما لم يكن الإنسان مع الله في اتصال دائم تضلُّ أعمالُه، ولو كان ذكياً، ويؤتى الحَذِرُ مِن مَأْمَنِه،
فالإنسان مهما كان ذكياً، فقد يرتكب حماقة ربما لا يفعلها الغبيّ، لأن الإنسان حينما يعتدّ بنفسه، وحينما يرى قوته، تكون هذه الرؤية المضلِّلة غشاوةً على عينيه، فبدَلَ أن يشجعه، وأن يثنيَ عليه، وأن يوافق على مقترحه، وصَفَه بالجبن والخنوع، وأنذَره بالويل والثبور، وهدّده بالتنحية عن القيادة،
قائد جيشٍ معه جنود، وبيده قوة في أطراف البلاد، فجمع عبد الرحمن وجوهَ الجند، وقادة الكتائب، وهذه الحكمة مِن الحكمة أيها الإخوة الكرام للمؤمنين فقط، لأنه لو كان الكافر يتمتع بحكمة، وفهم، وإدارك عميق، وتوازن، لَوَضَع الأمور في أماكنها، ووقف الموقف المناسب، لكن ما دام الإنسان مقطوع عن الله، أو بعيدًا عن الله، فلا بد أن يرتكب خطأً فاحشاً، وحماقة كبيرة، جمع عبد الرحمن وجوهَ الجند، وقادة الكتائب، وقرأ عليهم كتاب الحجاج، واستشارهم فيه، فَدَعَوْهُ إلى الخروج عليه، والمبادرة إلى نبذِ طاعته،
فقال لهم عبد الرحمن: أتبايعونني على ذلك، وتؤازرونني على جهاده، حتى يطهِّر اللهُ أرضَ العراق من رجسه، فبايعه الجند على ما دعاهم إليه، وسوف ترون بعد قليل حروبًا طاحنة، وآلاف القتلى، وفتنًا سببها موقف غير حكيم من الحجاج، هبَّ عبدُ الرحمن بن الأشعث بجيشه الممتلئ كراهيَةً للحجاج، ونشبتْ بينه وبين جيوش الثقفي معارك طاحنة، انتصر فيها نصراً مؤزراً، فتمّ له الاستلاء على جسستان، وجلِّ بلاد فارس، ثم أقبل ابنُ الأشعث يريد انتزاع الكوفة والبصرة من يدي الحجاج، وفيما كانت نيرانُ الحرب مشتعلة بين الفريقين، وكان ابن الأشعث ينتقل من ظفرٍ إلى ظفر، وقع للحجاج خطب زاد خصمه قوةً، ذلك أن ولاة الأنصار كتبوا إلى الحجّاج كتباً قالوا فيها: إن أهل الذمّة قد طفقوا يدخلون في الإسلام، ليتخلصوا من دفع الجزية، وقد تركوا القرى التي يعملون فيها، واستقرّوا في المدن، وأنّ الخراج قد اضمحلّ، وأنّ الجبايات قد أفلست.
هل تذكرون ماذا قال عمر بن عبد العزيز لما أرسل له أحد ولاته كتاباً أن هناك عددًا كبيرًا من أهل الذمة دخلوا في الإسلام، فقَلَّت الجزية والدخل، قال: واللهِ أتمنّى أن أعمل راعيَ غنمٍ أنا وأنت، ويدخلُ الناسُ كلهم في الإسلام،
إنسان من أهل الذمة، أعلن إسلامه، وانضم للمسلمين، لم يَعُدْ حينئذٍ مكلفًا بدفع الجزية، فماذا فعل الحجاج؟ كتب إلى ولاته في البصرة وغيرها كتباً يأمرهم فيها أن يجمعوا كل من نزح إلى المدن من أهل الذمة، وأن يعيدوهم إلى القرى مهما طال نزوحهم عنها، فصدع الولاة بالأمر، وأجْلَوْا أعداداً كبيرةً من هؤلاء عن ديارهم، وأبعدوهم عن موارد أرزاقهم، وحشدوهم في أطراف المدن، وأخرجوا معهم نساءهم وأطفالهم، ودفعوهم دفعاً إلى الرحيل إلى القرى،
بعد أن مضى على فراقهم لها حينٌ من الدهر، فأخذ النساءُ والولدانُ والشيوخُ يبكون، ويستصرخون، ويستغيثون، وينادون: وا محمداه، وحاروا فيما يفعلون، وإلى أين يذهبون، فخرج إليهم فقهاء البصرة، وقراؤها ليغيثوهم، ويشفعوا لهم، فلم يتمكنوا من ذلك، فطفقوا يبكون لبكائهم، ويستغيثون لمُصابهم.
الآن اغتنم عبد الرحمن بن الأشعث القائد الذي انشق عنه هذه الفرصة ودعا الفقهاء والقراء إلى مؤازرته، فاستجابت له كوكبة من جلّة التابعين، وعلى رأسهم سعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، وغيرهم، هنا النقطة، ينبغي على أهل العلم أن يبتعدُوا عن معترك السياسة، ودارت رحى الحرب بين الفريقين، وكان النصرُ أولَ الأمر لابن الأشعث ومَن معه على الحجاج وجنوده، ثم بدأت كفةُ الحجاج ترجح شيئاً فشيئاً، حتى هزم ابن الأشعث هزيمة منكرة، وفَرَّ ناجياً بنفسه، واستسلم جيشه للحجاج وجنوده، هنا بدأت القصة.
أمر الحجَّاجُ مناديَه أن ينادي في المقاتلين المهزومين، وأن يدعوهم لتجديد بيعته، فاستجاب أكثرهم له، وتوارى بعضهم عنه، وكان بين المتوارين سعيد بن جبير رَضِي اللَّه عَنْه وأرضاه، فلما أخذ المسلمون يتقدمون تباعاً لبيعته فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم، فلقد جعل يقول للواحد منهم: أتشهد على نفسك بأنك قد كفرت بنقض بيعتك لوالي أمير المؤمنين، فيجب أن يشهد على نفسه بالكفر، فإن قال: نعم، قَبِلَ منه تجديد بيعته، وأطلق سراحه، وإن قال: لا، قَتَلَه، فكان بعضهم يخضع له، ويقرُّ على نفسه بالكفر، لينقذ نفسه مِن القتل، وكان بعضهم الآخر يستكبر ذلك ويستنكره، فيدفع رقبته ثمناً لإبائه واستنكاره، ولقد ذاعت أخبار تلك الحادثة التي قتل فيها أشخاص كثيرون، ونجا منها أشخاص بعد أن دمغوا أنفسهم بالكفر، مِن ذلك أن شيخاً معمَّراً من قبيلة خثعم، كان معتزلاً للفريقين، مقيماً وراء الفرات، سِيق إلى الحجاج مع مَن سيقوا إليه، فلما ادخل عليه سأله عن حاله، فقال: مازلت منذ شبَت هذه النار معتزلاً وراء هذا النهر، منتظراً ما يسفرُ عنه القتال، فلما ظهرتَ وظفرتَ أتيتك مبايعاً، فقال: تباً لك، أتقعد متربصاً، ولا تقاتل مع أميرك، ثم زجره قائلاً: أتشهد على نفسك بأنك كافر، قال: بئس الرجل أنا إنْ كنتُ عبدت الله ثمانين عاماً، ثم أشهد بعد ذلك على نفسي بالكفر، ليس الأمرُ معقولاً، فقال له: إذاً أقتلك، قال: وإنْ قتلتني، فوالله ما بقي من عمري إلا ظمأ حمار، يعني ساعات قليلة، فإنه يشرب غدوة، ويموت عشية، وإني لأنتظر الموت صباحاً ومساء، فافعل ما بدا لك، فقال الحجاج لجلاده: اضرب عنقه، فضرب الجلاد عنقه، فلم يبق أحد في المجلس من شيعة الحجاج، أو من عدوه إلا أكبر الشيخ المعمر، ورثا له.
دعا كميل بن زياد النخعي، وقال له: أتشهد على نفسك بالكفر، فقال: والله لا أشهد، قال: إذاً أقتلك، قال: فاقضِ ما أنت قاض، وإنَّ الموعد فيما بيننا عند الله، وبعدَ القتل، فقال له الحجاج: ستكون الحُجَّة يومئذٍ عليك، لا لك، فقال له: ذلك إذا كنتَ أنت القاضيَ يومئذٍ، فقال الحجاج: اقتلوه، فَقَدِّم وقتل، قُدِّم إليه رجل آخر كان يكرهه الحجاج أشدّ الكراهية، ويشتهي أن يظفر بقتله، لِما كان ينقل له من سخريته به، فبادَره قائلاً: إني أرى أمامي رجلاً ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر، فقال له الرجل: لا تورطني، وتخدعني عن نفسي، أنا أكفر أهل الأرض، وأكفر من فرعون ذي الأوتاد، فخلّى سبيله، وهو يتحرق ظمأً لقتله.
نحن هنا دخلنا في القصة مرة ثانية، سعيد بن جبير إذا وقع بين يدي الحجاج فلا بد أن يقتله، فإما أن تُدَقَّ عنقُه، وإمّا أنْ يُقِرّ على نفسه بالكفر، وهما أمران أحلاهما مرٌّ، فآثر أن يخرج من بلاد العراق، وأن يتوارى عن الأنظار، وظلّ يضرب في أرض الله الواسعة مستخفياً عن الحجاج وعيونه، حتى لجأ إلى قرية صغيرة مِن أراضي مكة، وبقي على حاله هذه عشر حججٍ كاملات، عشر سنوات وهو متخفٍّ، كانت كافيةً أن تطفِئ نيران الحجاج المتّقدة في قلبه، وأن تزيل ما في نفسه من ضغنٍ عليه،
بَيْدَ أنه حدث ما لم يكن يتوقعه أحد، ذلك أنه قدم على مكة والٍ جديد من ولاة بني أمية، هو خالد بن عبد الله القسري، فتوجّس أصحاب سعيد بن جبير خِيفةً منه، لِمَا كان يعرفون من سوء سيرته، وتوقعوا الشرَّ على يديه، فجاء بعضهم إلى سعيد، وقال له: إنّ هذا الرجل قدِم مكة، وإنا واللهِ لا نأمنه عليك، فاستجبْ لطلبنا، واخرجْ من هذا البلد،
فقال: واللهِ لقد فررتُ حتى صرتُ أستحي من الله، ولقد عزمتُ على أن أبقى في مكاني هذا، وليفعْل اللهُ بي ما يشاء،
لم يكذب خالدًا ظنُّ السوء الذي ظنه الناس به، فما أنْ علِم بمكان سعيد بن جبير حتى أرسل إليه سرية من جنوده، وأمرهم أن يسوقوه مقيداً إلى الحجاج في مدينة واسط، فأطبق الجندُ على بيت الشيخ، وألقوا القيد في يديه على مرأى من بعض أصحابه، وآذنوه بالرحيل إلى الحجاج، فتلقاهم هادئ النفس، مطمئنَ القلب، ثم التفت إلى أصحابه،
وقال: ما أراني إلا مقتولاً على يد هذا الظالم، ولقد كنتُ أنا وصاحبان لي في ليلة عبادة، فاستشعرنا حلاوة الدعاء، فدعونا الله بما دعونا، وتضرّعنا إليه بما شاء مِن تضرع، ثم سألنا الله جل وعز أن يكتب لنا الشهادة، وقد رزقها اللهُ صاحبيَّ كليهما، وبقيتُ أنا أنتظرها،
ثم إنه ما كاد أن ينتهي من كلامه، حتى طلعت عليه بُنَيَّةُ صغيرة له، فرأته مقيداً، والجنودُ يسوقونه، فتشبثت به، وجعلت تبكي وتنشج، فنحاها عنه برفق، وقال لها: قولي لأمك يا بنية إن موعدنا الجنة إن شاء الله تعالى، ثم مضى، فبلغ الجندُ بالإمام الحبر العابد الزاهد التقي النقي الورع واسطًا، وأدخلوه على الحجاج.
فلما صار عنده، نظر إليه في حقد،
وقال: ما اسمك؟
قال: سعيد بن جبير،
فقال: بل شقي بن كسير،
قال: بل كانت أُمِّي أعلمَ باسمي منك،
قال: ما تقول في محمد؟
قال: تعني محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه،
قال: نعم،
قال: سيد ولد آدم، النبي المصطفى، خير من بقي من البشر، وخير من مضى، حمل الرسالة وأدى الأمانة، ونصح لله ولكتابه، ولعامة المسلمين، وخاصتهم،
قال: فما تقول في أبي بكر؟
قال: هو الصديق خليفة رسول الله، ذهب حميداً، وعاش سعيداً، ومضى على منهاج النبي صلوات الله وسلامه عليه، لم يغيِّر، ولم يبدل،
قال: فما تقول في عمر؟
قال: هو الفاروق الذي فرّق الله به بين الحق والباطل، وخيرة الله من خلقه، وخيرة رسوله، ولقد مضى على منهاج صاحبَيْه، فعاش حميداً، وقتل شهيداً،
قال: فما تقول في عثمان؟
قال: هو المجهِّزُ لجيش العسرة، الحافرُ لبئر رومة، المشتري لبيت لنفسه في الجنة، صهر رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ابنتيه، ولقد زوَّجه النبي بوحي من السماء، وهو المقتول ظلماً،
قال: فما تقول في عليِّ؟
قال: ابن عم رسول الله، وأول من أسلم من الفتيان، وهو زوج فاطمة البتول، وأبو الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة،
قال: فأي خلفاء بني أمية أعجب لك؟
قال: أرضاهم لخالقهم،
قال: فأيُّهم أرضى للخالق؟
قال: علمُ ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم، تحقيق طويل،
قال: فما تقول فيَّ؟
قال: أنت أعلم بنفسك،
قال: بل أريد علمك أنت،
قال: إذاً يسوءك ولا يسرك،
قال: لا بد من أن أسمع منك،
قال: إني لأَعْلَمُ أنك مخالف لكتاب الله تعالى، تُقدِم على أمور تريد منها الهيبة، وهي تقحمك الهلَكَةَ، وتدفعك إلى النار دفعاً،
قال: أمَا واللهِ لأقتلنك،
قال: إذاً تفسد عليَّ دنياي، وأفسد عليك آخرتك،
قال: اختر لنفسك أي قتلة شئت،
قال: بل اخترها أنت لنفسك يا حجّاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا وقتَلك اللهُ مثلها في الآخرة،
قال: أتريد أن أعفوَ عنك،
قال: إن كان العفو فمن الله تعالى، أمّا أنت، فلا أريده منك،
فاغتاظ الحجاج، وقال: السيف والنطع يا غلام،
فتبَسَّم سعيد،
فقال له الحجاج: وما تبسُّمك،
قال عجبت من جرأتك على الله، وحلم الله عليك،
قال: اقتله يا غلام، فاستقبل القبلة،
وقال: ( إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )
قال: حرِّفوه عن القبلة،
فقال: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)
قال: كبُّوه على الأرض،
فقال: ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى)
قال: اذبحوا عدو الله، فما رأيت رجلاً أَدْعَى منه لآيات القرآن الكريم،
فرفع سعيد كفَّيه، وقال: اللهم لا تسلِّط الحجاجَ على أحد بعدي،
قال: فلم يمضِ على مصرع سعيد بن جبير غيرُ خمسة عشر يوماً حتى حمَّ الحجاج، واشتدت عليه وطأةُ المرض، فكان يغفو ساعة ويفيق أخرى، فإذا غفا غفوة استيقظ مذعوراً وهو يصيح: هذا سعيد بن جبير آخذ بخناقي، هذا سعيد بن جبير، يقول: فيمَ قتلتني؟ ثم يبكي، ويقول: مالي ولسعيد جبير، ردّوا عني سعيد بن جبير.
الاستنباطات:
هناك استنباطات كثيرة،
العلم يجب أن يُنَحَّى عن المعترك الأرضي، هذا أكمل شيء له، وإلا نكون قد ضيَّعنا الدعوةَ إلى الله عز وجل.
الشيء الثاني، العبرة بهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، هذه لمَن كانوا على منهج الله، لمَن كانوا على سنّة رسوله، لمَن كانوا على الحق، والعبرة أن الإنسان بعد الموت يدفع الثمن باهظًا، وهذه القصة مؤلمة، وتضفي على المجلس بعض الحزن، لكن الحياة دار ابتلاء، ودار سعي، ودار امتحان، وعلى كلٍ فعلى الإنسان أنْ يكون على منهج الله سائراً، والحياةُ الدنيا لا قيمة لها، والجرأة قلَّ مثيلُها بين الناس، إنسان متمكن، وأعصابه قوية، يُدْلِي بالحُجّة، ويقول الحق دون خوف ووَجلٍ، ودون ارتباك وتردد، هذا من آثار الإيمان، لأن المؤمن حياته الدنيا يراها مؤقتة، والآخرة هي الحياة الحقيقية، والدليل قوله سبحانه وتعالى: ( يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي)
هذا معنى الحياة الأساسية، حياة الآخرة،
فأنا أقول: هنيئاً لمَن كان على الحق، ولتكن نهاية حياته ما تكون، لأن العبرة بهذا الأبد المديد الذي لا ينتهي، حيثُ يحكم فيه ملِكٌ عادل، والدنيا عرض حاضر، يأكل منه البَرُّ والفاجر، والآخرة وعدٌ صادقٌ، يحكم فيه مَلِكٌ عادلٌ.